 أسعار الدجاج في الاردن تخترق حاجز الدينارين ونصف
أسعار الدجاج في الاردن تخترق حاجز الدينارين ونصف
 العمل: لا زيادة على إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص
العمل: لا زيادة على إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص
 الاحتلال يستهدف سيارة الدفاع المدني الوحيدة بجباليا
الاحتلال يستهدف سيارة الدفاع المدني الوحيدة بجباليا
 أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي بالأردن
أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي بالأردن
 الإدارة الأميركية تمدد الإقامة القانونية لمليون مهاجر من 4 دول
الإدارة الأميركية تمدد الإقامة القانونية لمليون مهاجر من 4 دول
 إجراء 133 ألف فحص مخبري في المواصفات والمقاييس
إجراء 133 ألف فحص مخبري في المواصفات والمقاييس
 توحيد الرسوم الجمركية بين جميع المعابر السورية
توحيد الرسوم الجمركية بين جميع المعابر السورية
 مركز المناخ: اضطراب جوي في الشرق الاوسط قريبا
مركز المناخ: اضطراب جوي في الشرق الاوسط قريبا
 لازاريني: الأونروا الوصي الأمين لهوية وتاريخ لاجئي فلسطين
لازاريني: الأونروا الوصي الأمين لهوية وتاريخ لاجئي فلسطين
 إحباط محاولة تفجير داخل مقام السيدة زينب بدمشق
إحباط محاولة تفجير داخل مقام السيدة زينب بدمشق
 الداخلية: 52406 سوريين غادروا الأردن عبر معبر جابر
الداخلية: 52406 سوريين غادروا الأردن عبر معبر جابر
 650 مليون دينار القيمة المضافة لصناعة الجلدية والمحيكات بالأردن
650 مليون دينار القيمة المضافة لصناعة الجلدية والمحيكات بالأردن
 موظف مقهى يفتح النار على شاب .. والمحكمة تقول كلمتها
موظف مقهى يفتح النار على شاب .. والمحكمة تقول كلمتها
 معاريف عن ضباط كبار: حماس تستخدم الذخائر الإسرائيلية غير المنفجرة
معاريف عن ضباط كبار: حماس تستخدم الذخائر الإسرائيلية غير المنفجرة
 "مزارعو وادي الأردن": يجب تضافر الجهود لتذليل العقبات أمام الصادرات الأردنية
"مزارعو وادي الأردن": يجب تضافر الجهود لتذليل العقبات أمام الصادرات الأردنية
 اتفاقية لتعزيز التعاون بين غرفتي تجارة عمان وأبو ظبي
اتفاقية لتعزيز التعاون بين غرفتي تجارة عمان وأبو ظبي
 الأردن يستورد 1.855 مليون جهاز خلوي بقيمة 176 مليون دينار خلال 2024
الأردن يستورد 1.855 مليون جهاز خلوي بقيمة 176 مليون دينار خلال 2024
 الصندوقان الأسودان لطائرة كوريا الجنوبية توقفا عن التسجيل قبل 4 دقائق من التحطم
الصندوقان الأسودان لطائرة كوريا الجنوبية توقفا عن التسجيل قبل 4 دقائق من التحطم
 أوكرانيا: هجوم روسي شمل 74 طائرة مسيرة
أوكرانيا: هجوم روسي شمل 74 طائرة مسيرة

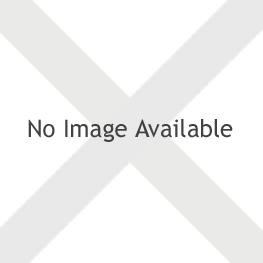
زاد الاردن الاخباري -
حين تجتاز البوابة السياحية في بترا باتجاه الموقع الأثري التاريخي لا تنتقل من مكان الى آخر فحسب، بل أيضاً من زمان الى سواه، لولا حركة السياح الأجانب الوافدين بكثرة من رياح الأرض الأربع لانفصلت بالكامل عن كل ما يربطك بالحاضر ماضياً في رحلة روحية أكثر منها سياحية، ذلك أن «الطقس البتراوي» العصيّ على الوصف أشبه بصلاة ومناجاة وارتحال نحو عوالم خالصة نقيّة مصفاة من أدران المعاصرة وشوائبها.
كأن ذاك الممر الصخري المتمادي المسمى «سيقاً» ما هو إلا طريق طويل نحو قيامة موعودة، لكنه ليس جلجلة ولا درب آلام، إنه سبيل خدر ومتعة مسبوقتين بدهشة عارمة حيال امتزاج جبروت الطبيعة برقّتها، قوّتها بهشاشتها، كمالها بنقصانها. هنا للصخر وجه آخر، هنا للصخر طبيعة أخرى. إنها رحم أنثوية هائلة تتشكل فيها أجنة الظلّ والضوء وتولد علامات ذهول على وجوه الداخلين اليها تأخذهم المنعرجات والشقوق والمنحنيات والنتؤات وما تسلّل من أشعة الشمس الى احشاء الحجر، من دهشة الى متعة، ومن متعة الى نشوة، ومن نشوة الى ارتقاء، ومن ارتقاء الى تجلّ، ومن تجلّ الى ذوبان، ومن ذوبان الى توحّد مع المكان ومبدعه الأكبر، نحّات الأكوان والمجرّات.
ثمة تمازج من نوع آخر يعيشه المنتشي في جوف الصخر، تمازج أكثر روعةً وبهاءً، بين يد الله ويد الإنسان، ولئن كان نحّات الأكوان والإنسان قد ترك بصمته في كل مكان وزمان، فإن الأخير شاء ردّ الجميل تاركاً لمسة مبدعه في مكان صار رحمه الثاني بعد أن قذفته أقداره وارحامه الى هذه اليابسة فراح يليّنها بالفنون التي ابتدأت نقوشاً وخطوطاً في الصخر والحجر قبل أن تصير لغات ولوحات ونوتات وقصائد وروايات. وهكذا فعل عربٌ أوائل اسمهم «الأنباط»، نحتوا في الجبال الصخرية بيوتاً ومعابد وهياكل وقبوراً ورموزاً وكلمات تقول أنهم كانوا هنا يوماً. مهلاً، لا ضرورة لفعل الماضي الناقص، لا ضرورة لـ «كانوا». فهؤلاء الأسلاف المبدعون ما زالوا هنا، في كل ما خلّفوه من إرث حضاري يقصده أهل الأرض من أربع رياحها، وينساه أحياناً أهله الأقربون الأولى بالدهشة والإكتشاف، حتى لو كان لا فضل لعربي على أعجمي في هذا السياق إلا بفضول المعرفة والسعي وراء بصمات الإبداع.
في أعماق الطبقات الصخرية تتجمّع المياه الجوفية لتتفجّر ينابيع وتتدفّق أنهاراً تمضي نحو مثواها غير الأخير في بحار الله الواسعة لتعود غيماً ثم مطراً يهطل ليمضي مجدداً الى باطن الأرض في دورة المياه المعروفة، بل في دورة الحياة التي يشيخ فيها كلَ حي إلا الماء. ولئن كان الصخر الذي يبدو جامداً قاسياً صلداً قادراً على احتضان المياه كرحم تحتضن جنيناً، فلا عجب إذاً، أن تمنح صخور البتراء زائرها ذاك الشعور العذب بالطراوة والليونة والتماوج الأخّاذ حتى يخال أنه – وهو يعبر السيق – بين ذراعي أنثى هائلة الحنان، ولا عجب كذلك أن تبزغ «الخزنة» في نهاية الممر الصخري كما تبزغ شمس منتصف الليل!!
باعثةٌ على الشعر والحبر والدهشة، كما هي باعثة على التساؤل والاستفهام: لماذا يأتيها الناس من الأقاصي ولا ينكبّ عليها العرب بحثاً وتمحيصاً ودراسةً خصوصاً أنها كمعلم أثري حضاري قد تكون الوحيدة على هذا النحو مما خلّفه الأسلاف العرب الأوائل. إنها، ولا غلو، «معلقة» كتبها «أنباطنا» في الصخر كأعجوبة تشهد لهم، ولبراعتهم، معلقة لا تقل ابداً عن معلّقاتهم الشعرية، مثلما لا تقل عما خلّفه الفراعنة واليونان والرومان والبيزنط والفرس والمماليك والعثمانيون والفرنجة وسواهم ممن مرّوا من هنا.
الفنون جنون. عبارة قديمة ربما قدم الإثنين معاً: الفنون والجنون. ولعل الفنون ما هي إلَا تعويض عن جنون غير متاح كل حين. أو لعلها على النقيض تماماً مضادات الجنون، فلولاها لما كانت الحياة على هذه اليابسة ممكنة. ألم نليّن وحشة هذا الكوكب بالموسيقى والشعر واللون؟ وهكذا فعل أسلافنا الانباط، ليّنوا الصخر بما تركوه فيه من نقوش تروي حكاية جديرة بأن نصغي اليها.
الحياة