 وزير الخارجية التركي: لا مطامع لتركيا في أي جزء من الأراضي السورية
وزير الخارجية التركي: لا مطامع لتركيا في أي جزء من الأراضي السورية
 وزير الخارجية السوري: سأزور دولا أوروبية في الفترة المقبلة
وزير الخارجية السوري: سأزور دولا أوروبية في الفترة المقبلة
 الاتحاد الأوروبي: قد يخفف العقوبات على سوريا في حال حصول "تقدم ملموس"
الاتحاد الأوروبي: قد يخفف العقوبات على سوريا في حال حصول "تقدم ملموس"
 ميقاتي: سنبدأ بنزع السلاح من جنوب البلاد
ميقاتي: سنبدأ بنزع السلاح من جنوب البلاد
 الاحتلال ينفذ اعتداءات بالخليل ومستوطنون يحرقون ممتلكات فلسطينية
الاحتلال ينفذ اعتداءات بالخليل ومستوطنون يحرقون ممتلكات فلسطينية
 وزارة الدفاع السورية تواصل عقد جلسات دمج الفصائل بالجيش
وزارة الدفاع السورية تواصل عقد جلسات دمج الفصائل بالجيش
 كاتس: لا يجوز الانجرار لحرب استنزاف مع حماس
كاتس: لا يجوز الانجرار لحرب استنزاف مع حماس
 إيران تتوعد إسرائيل بقوة هجومية ودفاعية جديدة وتكشف عن مسيّرة انتحارية
إيران تتوعد إسرائيل بقوة هجومية ودفاعية جديدة وتكشف عن مسيّرة انتحارية
 ترامب: بوتين يريد لقائي ونحن نرتّب لذلك
ترامب: بوتين يريد لقائي ونحن نرتّب لذلك
 اجتماع أميركي أوروبي في روما لتقييم الوضع بسوريا بعد سقوط نظام الأسد
اجتماع أميركي أوروبي في روما لتقييم الوضع بسوريا بعد سقوط نظام الأسد
 ترودو يصف تهديدات ترامب بـ"تكتيك" لصرف الانتباه عن الرسوم الجمركية
ترودو يصف تهديدات ترامب بـ"تكتيك" لصرف الانتباه عن الرسوم الجمركية
 غوتيريش يدعم سيادة لبنان وفقا لاتفاق الطائف وإعلان بعبدا
غوتيريش يدعم سيادة لبنان وفقا لاتفاق الطائف وإعلان بعبدا
 مواعيد مباريات اليوم الجمعة 10 - 1 - 2025 والقنوات الناقلة
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 10 - 1 - 2025 والقنوات الناقلة
 تقرير أممي: النمو الاقتصادي العالمي سيظل منخفضا وسط استمرار عدم اليقين
تقرير أممي: النمو الاقتصادي العالمي سيظل منخفضا وسط استمرار عدم اليقين
 مجلس عجلون: خصصنا 295 ألف دينار من موازنة 2025 لقطاع الزراعة
مجلس عجلون: خصصنا 295 ألف دينار من موازنة 2025 لقطاع الزراعة
 مجلس الأمن يرحب بانتخاب جوزاف عون رئيسا للبنان
مجلس الأمن يرحب بانتخاب جوزاف عون رئيسا للبنان
 بايدن: نحرز تقدما بشأن الاتفاق في غزة
بايدن: نحرز تقدما بشأن الاتفاق في غزة
 رويترز: وسطاء أميركيون وعرب يحرزون بعض التقدم بشأن غزة لكن لا اتفاق
رويترز: وسطاء أميركيون وعرب يحرزون بعض التقدم بشأن غزة لكن لا اتفاق
 ارتفاع أسعار النفط بدعم من زيادة الطلب على الوقود
ارتفاع أسعار النفط بدعم من زيادة الطلب على الوقود

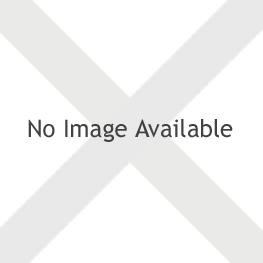
زاد الاردن الاخباري -
بقلم: عبدالله المغلوث
دون أن أقصد تسببت في جريمة بأمريكا. فلم أفتح الباب لسيدة كبيرة في السن كانت تسير خلفي وأنا أهم بالخروج من باب مجمع تجاري. ارتطمت السيدة بالباب وتعثرت وتبعثرت أغراضها على الأرض دون أن تصاب بأي أذى. لكن خلال محاولتي مساعدتها في جمع أشلاء أكياسها سألني رجل أمن أن أرافقه إلى مكتب الإدارة في المجمع بصوت عال كالذي ينادي به اللصوص.
ذهبت معه مرددا في نفسي: *اللهم لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه*. وفور أن دخلت المكتب دار بيننا الحوار التالي، والذي بدأه بسؤال فظ: *هل لديك مشاعر؟*.
أجبته باقتضاب: *بالتأكيد*.
فرد ووجهه يفيض غضبا: *لماذا إذاً لم تفتح الباب للسيدة التي وراءك؟*.
رددت عليه قائلا: *لم أرها. فلا أملك عينين في مؤخرة رأسي*.
فقال وهو يبحث عن قارورة الماء التي أمامه ليطفئ النار التي تشتعل في أعماقه إثر إجابتي التي لم ترق له: *عندما تقود سيارتك يتوجب عليك أن تراقب من هو أمامك ومن خلفك وعن شمالك ويمينك. فمن الأحرى أن تكون أكثر حرصا عندما تقود قدميك في المرة المقبلة*.
شكرته على النصيحة، فأخلى سبيلي معتذرا عن قسوته، مؤكدا أن تصرفه نابع من واجبه تجاه أي شخص يبدر منه سلوكا يراه غير مناسب.خرجت من مكتبه وأنا أهطل عرقا رغم أن درجة الحرارة كانت تحت الصفر وقتئذ في ولاية يوتاه بغرب أمريكا.
كان درسا مهما تعلمته في سنتي الأولى في أمريكا عام 2000. فأصبحت منذ ذلك الحين أفتح الأبواب لمن أمامي وخلفي وعن يميني وشمالي. ومن فرط حرصي أمسكه لمن يلوح طيفه من بعيد في مشهد كوميدي تسيل على إثره الضحكات.
فتح الأبواب في المجمعات التجارية والمستشفيات والجامعات يعد سلوكا حضاريا ويعكس ثقافة تجيدها دول العالم الأول مما جعلها تقطن الصدارة، فيما نقبع في المؤخرة. لا أقصد فقط الأبواب الفعلية التي نعبرها في أماكننا العامة بل أيضا الأبواب الافتراضية التي تقطننا وتشغلنا. في يقظتنا وأحلامنا. باب الوظيفة وباب الترقية وباب الفرصة.
هذه الأبواب التي يملك بعضنا مفاتيحها ومقابضها بيد أنها للأسف لا تفتح إلا لمن نحب ونهوى. لمن له منزلة في نفوسنا وقلوبنا، مما أدى إلى ارتطام وسقوط الكثير من الموهوبين، ممن لا حول لهم ولا قوة، أمام هذه الأبواب، متأثرين بجراحهم ومعاناتهم. فأبوابنا موصدة ومغلقة إلا أمام قلة قليلة لهم الحظوة والشفاعة وربما ليس لديهم أدنى الإمكانات للحصول على وظيفة معينة أو فرصة تتطلب مواصفات ومعايير محددة.
في حفل تخرج صديقي من جامعة مانشستر ببريطانيا العام الماضي تأثرت بكلمة الخريجين التي ارتجلها طالب سوداني حصل على درجة الدكتوراه في الهندسة. سحرتني كلمته القصيرة التي قال فيها: *لن أفسد فرحتكم بكلمة طويلة مملة. سأختزلها في جملتين. دكتور جون فرانك، شكرا لأنك فتحت باب مكتبك وعقلك لي. هذا الباب هو الذي جعلني أصعد هذه المنصة اليوم وأزرع حقول الفرح في صدر جدتي مريم*.
قطعا، لا يرتبط السوداني صلاح كامل وأستاذه جون فرانك بوشائج قرابة وروابط دم. لكن الأخير آمن بمشروع طالبه فشرع له أبواب طالما اصطدم بها في وطنه وعدد من الدول العربية. يقول صلاح وهو يدفع عربة جدته التي جاءت إلى بريطانيا خصيصا لتتقاسم مع حفيدها الوحيد فرحته بالحصول على الشهادة الكبيرة: *الدكتور فرانك الوحيد الذي أصغى إلي. طفت دولا عربية كثيرة وجامعات عديدة ولم أجد أذنا صاغية*.
إن مجتمعاتنا العربية تحفل بالأنانية وحب الذات. فتكاتفنا وتعاوننا وفتح الأبواب لبعضنا البعض سيثمر نجاحا غفيرا. يقول المفكر الفرنسي، لاروشفوكو: *الأنانية كريح الصحراء.. إنها تجفف كل شيء*.
ثمة حل واحد يقودنا لإفشاء الإبداع وإشاعة النجاح وهو نكران الذات وإعلاء محبة الإنسان عاليا وتطبيقه في كل معاملاتنا. وليبدأ كل واحد منا بسؤال نفسه قبل أن يخلد إلى النوم: *كم بابا فتحت اليوم*. إجاباتنا ستحدد إلى أين نتجه. فماذا ننتظر من مجتمعات مغلقة لا تفتح الأبواب... لاشك أنها تركض وراء السراب؟