 إغلاقات وتشميع محلات بالشمع الأحمر في إربد .. وهذا السبب
إغلاقات وتشميع محلات بالشمع الأحمر في إربد .. وهذا السبب
 الأردن .. 4 اصابات بتدهور مركبة على طريق المفرق
الأردن .. 4 اصابات بتدهور مركبة على طريق المفرق
 الأردن .. جلسة مغلقة لمجلس النواب اليوم
الأردن .. جلسة مغلقة لمجلس النواب اليوم
 استمرار تأثير الكتلة الهوائية الباردة جدا على الأردن
استمرار تأثير الكتلة الهوائية الباردة جدا على الأردن
 الأردن .. ارتفاع الطلب على الألبسة الشتوية مع بدء الموسم
الأردن .. ارتفاع الطلب على الألبسة الشتوية مع بدء الموسم
 المحروقات: ارتفاع الطلب على الغاز المنزلي 113%
المحروقات: ارتفاع الطلب على الغاز المنزلي 113%
 الأرصاد توضح حول توقعات سقوط الثلوج في الأردن
الأرصاد توضح حول توقعات سقوط الثلوج في الأردن
 عشيرة المعايطة تؤكد إدانتها وتجريمها للاعتداء الإرهابي على رجال الأمن العام
عشيرة المعايطة تؤكد إدانتها وتجريمها للاعتداء الإرهابي على رجال الأمن العام
 إصابات جراء سقوط صاروخ على مخيم طولكرم
إصابات جراء سقوط صاروخ على مخيم طولكرم
 دورة تدريبية حول حق الحصول على المعلومات في عجلون
دورة تدريبية حول حق الحصول على المعلومات في عجلون
 خطة لإنشاء مدينة ترفيهية ونزل بيئي في عجلون
خطة لإنشاء مدينة ترفيهية ونزل بيئي في عجلون
 بلدية اربد: تضرر 100 بسطة و50 محلا في حريق سوق البالة
بلدية اربد: تضرر 100 بسطة و50 محلا في حريق سوق البالة
 وزارة الصحة اللبنانية: 3754 شهيدا منذ بدء العدوان الإسرائيلي
وزارة الصحة اللبنانية: 3754 شهيدا منذ بدء العدوان الإسرائيلي
 الحمل الكهربائي يسجل 3625 ميجا واط مساء اليوم
الحمل الكهربائي يسجل 3625 ميجا واط مساء اليوم
 دائرة الضريبة تواصل استقبال طلبات التسوية والمصالحة
دائرة الضريبة تواصل استقبال طلبات التسوية والمصالحة
 الأمير علي لـ السلامي: لكم مني كل الدعم
الأمير علي لـ السلامي: لكم مني كل الدعم
 غارتان إسرائيليتان على ضاحية بيروت الجنوبية بعد إنذار بالإخلاء
غارتان إسرائيليتان على ضاحية بيروت الجنوبية بعد إنذار بالإخلاء
 رئيس مجلس النواب يزور مصابي الأمن في حادثة الرابية
رئيس مجلس النواب يزور مصابي الأمن في حادثة الرابية
 الأردن .. تعديلات صارمة في قانون الكهرباء 2024 لمكافحة سرقة الكهرباء
الأردن .. تعديلات صارمة في قانون الكهرباء 2024 لمكافحة سرقة الكهرباء

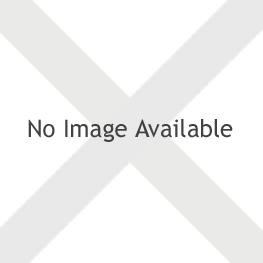
في الوضعِ الأمثل، يكون للمُعلّم سُلطة الأبِ أو أكثر، ولا أعني بالسلطة مصدر الخوف والإلزام، بل المرجعيّة التي تُستمد منها القيمُ والأخلاقُ والمُثلُ. أما في الوضع غير القويم الذي نشهده هذه الأيام، فدورُ المُعلّم هامشيٌّ إلى أبعد حد، وهيبة المُعلّم في تراجعٍ يُثير الأسفَ والتساؤل. فما عادَ المعلّم صاحب حضورٍ بهيّ، ولا بقي له ذلك الدورُ الذي يُكمل دور الأسرة والدين والأخلاق، فالأجيالُ أُشغلت عن طلبِ العلم باللُهاث وراء الثانويّـات، تاركةً الأساسيات على هامش الحياة والاهتمام. والأمرُ يُنذر بشرٍ مستطير قد نستطيع تحديد بدايته، لكننا سنعجزُ حتماً عن التنبؤ بمساره ومنتهاه. ولن أذيعَ سرّاً إذا أنحيت باللائمة على السياسات المتبعة في إدارة قطاع التعليم، وهو القطاعُ الذي يؤسس لنهضةٍ أو يقودُ لخراب، فهذه السياسات، لم ترتكز على منظورٍ إستراتيجي يقومُ على أهدافٍ يسعى لتحقيقها ويحشد لذلك كل ممكنٍ ومتسطاع. فغياب الرؤيا قادَ إلى تناقضِ السياسات مع الأهداف، وعدم استقرار السياسات قادَ بدوره إلى الفشل في الوصول إلى الأهداف المأمولة من العملية التعليمية. وبالتوازي مع هذا الخلل الجسيم، تدهور وضعُ المعلّم اقتصادياً ومعاشياً. ولأن القيّم آخذةٌ في التراجع فقد علت قيمةُ المادةِ على ما سواها، فتدهور بالتالي وضع المعلّم اجتماعياً وفقدَ المكانة التي حظيَ بها في الماضي غير البعيد عن أيامنا وما فيها من مفارقات تبعثُ على الآسى. ولأن المدرسةَ هي أساس كل حضارة، فقد أفسد تدهور مكانتها علينا حياتنا، فتطاول التلميذ على مَنْ يعلّمه الحروف ضرباً وشتماً وتحقيراً، وصار المعلّم مجنيّاً عليه في غالبِ الأحوال، وتصيّد الجميع هفوة معلّم هنا أو هناك ليعمموا، وليتخذوا من ذلك ذريعةً لمزيدٍ من التحجيم والتقزيم للمعلّم ودوره ورسالته. وبهامشٍ بسيطٍ من الاختلاف فإن دور الأستاذ في الجامعة – وهو معلّمٌ بالدرجةِ الأولى- يمرُ بأزمةٍ هو الآخر. أزمةُ دورٍ ورسالة جعلت من الأستاذ في الجامعة في الغالب مجرد مدرّسٍ لمادةٍ أكاديمية بحتةٍ لا مربٍ له دوره الكبير في صناعة الأجيال وغرس القيّم ورعايتها. إن للعلمِ رسالة ورُسل، وإن للمعلّم حضورٌ آخذٌ في التلاشي. وعلى منظريّ وصنّاع السياسة والقرار أن ينتبهوا لما آلت إليه أحوالُ الرسالة والرُسل. وأن يعيدوا تعريفَ وصياغة السلطة الأكاديمية للرسالة والرُسل قبل أن نتحسر على رسالةٍ ضيّعناها ورسلٍ فوضوا أمرهم إلى الله .