 الاحتلال يقصف مستشفى كمال عدوان شمال القطاع .. "الأوكسجين نفد" (شاهد)
الاحتلال يقصف مستشفى كمال عدوان شمال القطاع .. "الأوكسجين نفد" (شاهد)
 الأردن يوقع بيانًا لإقامة علاقات دبلوماسية مع تيمور الشرقية
الأردن يوقع بيانًا لإقامة علاقات دبلوماسية مع تيمور الشرقية
 القناة 12 : “إسرائيل” ولبنان قريبان من اتفاق في غضون أيام
القناة 12 : “إسرائيل” ولبنان قريبان من اتفاق في غضون أيام
 المومني: دعم الصحافة المتخصصة أمر أساسي وأولوية
المومني: دعم الصحافة المتخصصة أمر أساسي وأولوية
 بوتين يهدد بضرب الدول التي تزود أوكرانيا بالأسلحة .. "الباليستي رد أولي"
بوتين يهدد بضرب الدول التي تزود أوكرانيا بالأسلحة .. "الباليستي رد أولي"
 شحادة: السماح لجنسيات مقيدة بدخول الاردن يهدف لتعزيز السياحة العلاجية وإعادة الزخم للقطاع
شحادة: السماح لجنسيات مقيدة بدخول الاردن يهدف لتعزيز السياحة العلاجية وإعادة الزخم للقطاع
 ماذا تعني مذكرات التوقيف بحق نتنياهو .. ما القادم والدول التي لن يدخلها؟
ماذا تعني مذكرات التوقيف بحق نتنياهو .. ما القادم والدول التي لن يدخلها؟
 جرش .. مزارعون ينشدون فتح طرق إلى أراضيهم لإنهاء معاناتهم
جرش .. مزارعون ينشدون فتح طرق إلى أراضيهم لإنهاء معاناتهم
 موجة برد سيبيرية تندفع إلى الأردن الأسبوع المقبل مسبوقة بالأمطار
موجة برد سيبيرية تندفع إلى الأردن الأسبوع المقبل مسبوقة بالأمطار
 خبير عسكري: صواريخ أتاكمز الأميركية ستنفجر بوجه واشنطن
خبير عسكري: صواريخ أتاكمز الأميركية ستنفجر بوجه واشنطن
 قروض حكومية بدون فوائد لهذه الفئة من المواطنين
قروض حكومية بدون فوائد لهذه الفئة من المواطنين
 الأردن .. 750 مليون دينار العائد الاقتصادي للطلبة الوافدين
الأردن .. 750 مليون دينار العائد الاقتصادي للطلبة الوافدين
 ريال مدريد عينه على (الصفقة الصعبة).
ريال مدريد عينه على (الصفقة الصعبة).
 أيرلندا :نؤيد الجنائية الدولية بقوة
أيرلندا :نؤيد الجنائية الدولية بقوة
 السرطان يهدد بريطانيا .. سيكون سبباً رئيسياً لربع الوفيات المبكرة في 2050
السرطان يهدد بريطانيا .. سيكون سبباً رئيسياً لربع الوفيات المبكرة في 2050
 أستراليا تتجه لسن قانون يمنع الأطفال من وسائل التواصل
أستراليا تتجه لسن قانون يمنع الأطفال من وسائل التواصل
 أمريكا ترفض قرار الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وجالانت
أمريكا ترفض قرار الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وجالانت
 النفط يرتفع وسط قلق بشأن الإمدادات من جراء التوترات الجيوسياسية
النفط يرتفع وسط قلق بشأن الإمدادات من جراء التوترات الجيوسياسية
 ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 44056 شهيدا
ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 44056 شهيدا

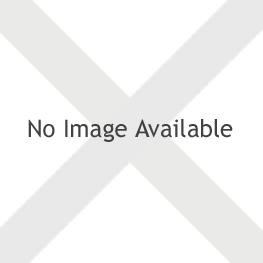
ثمة حقيقة يجدها الإنسان المفكر في توعية لذاته، وهي الشعور بقدرته على إخضاع كل شيء لفكره، حالما يتحصن في قلعة شخصه ، و تعزله ملكاته، و يدخل في تجربته الخاصة، في ميادين القلق الروحي و الفكري. فالقلق ليس إلا شكلاً من تجربة المفكر و الأديب، و هو روح الإبداع المتوقد في ذهن الفنان، و الشاعر، و هو سر نجاحنا، أو فشلنا في السيطرة على الطبيعة، وإدراك حقائق الوجود. و في تاريخنا الإنساني ، المفعم بالأسرار، كان للقلق تأثير عميق في حياة الإنسان، منذ وجد على ظهر الأرض، فهو رفيق الأنبياء، و عنوان النبوة في تجربة إبراهيم عليه السلام. فقد نظر في السماء ، فرأى كوكباً، فقال:" هذا ربي" ثم اتبعه ببصره حتى غاب " فلما أفل قال لا أحب الآفلين" ثم نظر إلى القمر ، فرآه بازغاً، فقال:"هذا ربي"، ثم اتبعه ببصره حتى غاب "فلما أفل قال لئن لم يهدن ربي لاكونن من القوم الضالين". فالقلق ، كان التربة الغنية ،التي غذت عملية التذكير في تجربة إبراهيم _عليه السلام_،لكنه فشل في مراحلها الأولى ، فشل في الوصول إلى الحقيقة، وأراد أن يستمر في التجربة الخاصة، مستنداً على إرادته الحرة في التفكير المطلق، و بأنه قادر على مقاومة كل شيء. فلما دخل عليه النهار، و طلعت الشمس قال:" هذا ربي ، هذا اكبر، فلما افلت قال: يا قوم إني بريء مما تشركون ، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات و الأرض ، حنيفاً وما أنا من المشركين". هذا القلق الروحي، خلق في قلب إبراهيم _عليه السلام_ نوعاً من الوعي المتمرد، جعله يدخل إلى بيت الآلهة، فراغ عليهم ضرباً باليمين. وفي محاكمته العلنية أمام الملك نمرود، قال له: من هو ربك هذا يا إبراهيم، الذي تدعو إلى عبادته ؟! "قال إبراهيم: ربي الذي يحيي و يميت " فقال نمرود: فأنا " احيي و أميت " فقال إبراهيم:" فان الله يأتي بالشمس من المشرق، فات بها من المغرب" "فبهت الذي كفر" فانتصر القلق بقوة التجربة الخاصة، و انهزم الباطل بوقوع الحجة. هذا الاضطراب و القلق، لم يتنام و يكبر، إلا حول تجربة روحية قلقة، وإذا ما بحثنا عن المكان، الذي تأخذ فيه التجربة مكانها، فإن اصح مدلول لها في عالم الفكر، يجب أن نقول حسب اعتقادنا، أن المكان الذي لا يستهان به، و الذي تشغله هذه التجربة الروحية القلقة، هو القلب. فالقلب محكمة الإنسان العادلة، و علينا أن نقر بأهمية القلق في حياة المفكر، و الأديب، فهو عندما يعمل بجميع الوسائل، لطرد هذا القلق عن نفسه، و يرتاح، فإنه في الواقع يثري تجربتنا الحياتية، و يساعدنا على التقدم و تطوير أنفسنا، في الوصول إلى الحقيقة. إن هذه التجارب الخاصة، لا تتجلى عن طريق القمع، أو الاستبداد، و التصعيد، اللذين يألفهما الواقع الفكري، و الثقافي، والروحي أيضا، بل عن طريق تنامي هيمنة واعية، تبلغ الذروة بتبلور حقيقي. فلو كنا قد بلغنا رؤية الحقيقة ملياً، لما بقينا ننشدها، لكن طالما لم نزل في طور البحث، فإننا نواصل بحثنا ، و نعي عدم كمالنا، ولسوف تظهر في الأفق حقائق كثيرة، تجعلنا نأسف على ما فاتنا من شمولية الوعي. إننا لم نحقق الفكر في كماله، و طالما أن الفكر البشري، كما نتصوره هو غير كامل، فهو قابل أبدا للتطور و البحث، والتعليل،و إعادة النظر، للارتقاء نحو الحقيقة،وهذا ما لا يتحقق، إلا بوجود التجربة الخاصة، المبنية أساسا على القلق المصاحب لعملية التفكير، كما لاحظنا في تجربة أبي الأنبياء عليه السلام. إن جميع التصورات الذهنية، التي يتمثلها الناس هي غير كاملة، و تشكل تجليات للحقيقة في ثوب من القلق و التردد، لأنها جميعها قابلة للخطأ. إن الاحترام الذي نكنه لضروب أخرى من التفكير، لا يجوز أن تحجب عنا عيوبها، وعلينا أن نعي بشدة،عيوب تجاربنا الخاصة، و مع ذلك، لا يجوز أن نتخلى عن هذه التجارب، بل علينا التغلب على تلك العيوب. فالتجربة ليست خطأ، ولكن الخطأ هو التحيز إلى تجارب خاصة، مع علمنا بأنها غير كاملة. وإذا كنا لا نتردد في اقتباس التجارب الذاهبة في الاتجاه الصحيح، فالواجب علينا أن نحترم التجارب الأخرى، ونقدرها، حتى يثبت لنا صحتها، أو بطلانها, على طريقة: "و اعبد ربك حتى يأتيك اليقين".