 مؤشرات على تقدم بمفاوضات الصفقة وترامب يريد اتفاقا خلال أيام
مؤشرات على تقدم بمفاوضات الصفقة وترامب يريد اتفاقا خلال أيام
 الترخيص المتنقل في دير أبي سعيد غدا
الترخيص المتنقل في دير أبي سعيد غدا
 مصادر عبرية تكشف تفاصيل الصفقة المرتقبة بين حماس وإسرائيل
مصادر عبرية تكشف تفاصيل الصفقة المرتقبة بين حماس وإسرائيل
 انخفاض الاسترليني أمام الدولار
انخفاض الاسترليني أمام الدولار
 أوامر إخلاء جديدة في لوس أنجلوس بعد تغيير في اتجاه أكبر الحرائق
أوامر إخلاء جديدة في لوس أنجلوس بعد تغيير في اتجاه أكبر الحرائق
 السفارة الأمريكية في الأردن :بنحب نبشركم!
السفارة الأمريكية في الأردن :بنحب نبشركم!
 بالتفاصيل .. عودة المنخفضات الجوية الباردة الى الأردن
بالتفاصيل .. عودة المنخفضات الجوية الباردة الى الأردن
 شولتس: احترام الحدود "ينطبق على جميع البلدان"
شولتس: احترام الحدود "ينطبق على جميع البلدان"
 تفاصيل جديدة عن إحباط محاولة تفجير مقام السيدة زينب بدمشق
تفاصيل جديدة عن إحباط محاولة تفجير مقام السيدة زينب بدمشق
 الاحتلال يرتكب 5مجازر في غزة خلال 48 ساعة
الاحتلال يرتكب 5مجازر في غزة خلال 48 ساعة
 الشرع: فرصة مبنية على سيادة لبنان وسوريا
الشرع: فرصة مبنية على سيادة لبنان وسوريا
 ارتفاع عدد المركبات الكهربائية في الأردن بنسبة 29% في عام 2024
ارتفاع عدد المركبات الكهربائية في الأردن بنسبة 29% في عام 2024
 ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 46537 شهيدا و109571 مصابا
ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 46537 شهيدا و109571 مصابا
 علان: 50% إنخفاض إقبال الأردنيين على شراء الذهب في 2024
علان: 50% إنخفاض إقبال الأردنيين على شراء الذهب في 2024
 الرئاسة اللبنانية: السعودية ستكون أول مقصد للرئيس عون في زياراته الخارجية
الرئاسة اللبنانية: السعودية ستكون أول مقصد للرئيس عون في زياراته الخارجية
 ارتفاع عدد الشركات المسجلة في الاردن 5 %
ارتفاع عدد الشركات المسجلة في الاردن 5 %
 إطلاق البرنامج التنفيذي لتطبيق الإطار الوطني للأمن السيبراني في 100 مؤسسة
إطلاق البرنامج التنفيذي لتطبيق الإطار الوطني للأمن السيبراني في 100 مؤسسة
 الأعلى للسكان: 21% من قوة العمل في الأردن عمالة وافدة قانونية
الأعلى للسكان: 21% من قوة العمل في الأردن عمالة وافدة قانونية
 فريق الحسين إربد يتوج بلقب كأس الأردن تحت سن 19
فريق الحسين إربد يتوج بلقب كأس الأردن تحت سن 19

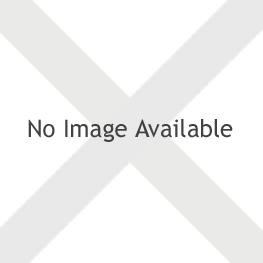
زاد الاردن الاخباري -
خلصت دراسة علمية حول العنف في المجتمع الأردني، أعلنها المجلس الاقتصادي والاجتماعي امس، الى أن أحداث العنف، التي زادت حدتها خلال العامين الاخيرين في المملكة "اتسمت بتحولها من خلافات أو جرائم فردية إلى مواجهات جماعية عنيفة بين مجموعات من الأهالي أو الطلبة".
وبينت الدراسة أن ما كان ينقل الحادث الفردي إلى مستوى مقلق من العنف المجتمعي، الذي شمل مناطق متعددة من البلاد بما فيها عدد من الجامعات، انها كانت تقع على خلفية استثارة العصبية القبلية أو الجهوية وغيرها من الهويات الفرعية.
وعلى الرغم من ان الدراسة اكدت ان العنف ليس صفة من صفات المجتمع الاردني، فإنها حذرت من أنه قد يصبح جزءا من ثقافة اية جماعة في ظروف اجتماعية او سياسية او اقتصادية محددة.
وزادت ان البعض قد يلجأ للعنف "حينما يرى أن جماعات وأفراداً مارسوا العنف أو أشكالا أخرى من التطاول على القانون، وحققوا مكاسب ولم يحاسبوا، في الوقت الذي تمارس فيه بعض الجهات الرسمية سياسة استرضائية تجاههم لوقف اعتداءاتهم على الممتلكات العامة وقوى الأمن".
وأشارت الدراسة، التي حملت عنوان "سيادة القانون: أمان المواطن وأمن الوطن" وعرضها رئيس المجلس الاجتماعي الاقتصادي عبد الإله الخطيب، في مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الاردنية امس، إلى ان العنف سلوك مكتسب وليس قَدَراً مفروضاً على المجتمعات، وبأنه من المظاهر التي يمكن تغييرها، إذا ما تم تشخيص أسبابها بنجاح واتخاذ الإجراءات والعلاج المناسبين حيالها.
ولفتت الدراسة الى ان ازدياد الأوضاع الاقتصادية صعوبة، وضعف قنوات التعبير والتواصل، وتنامي اعتماد الواسطة والمحسوبية، أدت إلى تزايد دور الهويات الفرعية في حياة المجتمعات المحلية.
وبينت أنه، في ظل الاختلالات التنموية والضغوط التي تتعرض إليها الطبقة الوسطى، بما يؤثر على ثقافتها، اندفعت فئات عديدة إلى الاستعاضة عن الأطر المدنية والسياسية في تحقيق طموحاتها السياسية والاجتماعية، بالعودة الى الأطر التقليدية المعبرة عن تلك الهويات الفرعية.
واستغل البعض ذلك، إلى محاولة توظيف العشائرية لخدمة أغراضه الذاتية، بما يسيء للعشيرة كوحدة اجتماعية أساسية، ولدورها التاريخي الذي يعتز به الأردنيون، بوصفها داعماً أساسياً للبناء الوطني ولسلطة الدولة واستقرار نظامها السياسي.
ورأت الدراسة ان هناك قصورا في بعض التشريعات الجزائية عن تحقيق الردع الفعال لأنماط الجرائم، التي تنال من هيبة الدولة وتلحق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة.
ولفتت الدراسة الى ان بعض القوانين والأنظمة، التي تتعلق باقتناء السلاح وحمله، اصبحت بحاجة إلى مراجعة لتصبح أكثر تقييداً، إلى جانب الاستمرار في سحب السلاح غير المرخص.
ورأت الدراسة ان مجموعة من العوامل المتداخلة في المرحلة الانتقالية الحالية، التي يمر بها المجتمع، تسهم في تقوية الميل نحو عدم الالتزام بالقانون، وبالتجاوز عليه.
وأكدت أهمية تكافل سائر الأطراف للتوصل إلى مقاربات متسقة تعالج مختلف أوجه الخلل، وصولاً إلى خلق تلك البيئة المجتمعية، التي تكفل الاحتكام للقانون لتنظيم حياة المجتمع بصورة شاملة.
وربطت الدراسة العوامل بتطورات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية خلال العقدين الماضيين، التي نجم عنها تبدلات في السلوك العام، ومنظومة القيم كالانتخابات النيابية والبلدية، بخاصة الأخيرة، والتي أفرزت في ظل استمرار ضعف الأحزاب والقوى السياسية، مجالس ذات طابع تمثيلي ضعيف للمجتمع ولتطلعات أبنائه.
أما على الصعيد الاقتصادي، فقد ولَّدَ تغير دور القطاع العام إحساساً بالابتعاد عن المؤسسات الرسمية لدى قطاع واسع من المواطنين، بحسب الدراسة، التي رأت أن السياسات الاقتصادية لم تنجح في تصحيح الاختلالات في توزيع الدخل القومي، وهو ما عمق الاستقطاب الاجتماعي، وأدى إلى تقلص الطبقة الوسطى، التي تشكل قاعدة الاستقرار في المجتمع.
أما الخلل الذي يستدعي المعالجة فيتصل بالأبعاد القضائية، إذ بينت الدراسة ان هناك بطئاً شديدا في البت بالقضايا المنظورة أمام المحاكم، وبخاصة تلك التي لها تداعيات عائلية وعشائرية، وهو ما يضعف الثقة بالقضاء، وبقدرته على إحقاق الحق بالسرعة المناسبة، ويؤكد أن "تأخير العدالة يساوي إنكارها".
ولفتت الدراسة الى ان ما يؤخر إجراءات التقاضي، أن قسماً كبيراً من مذكرات الإحضار التي يصدرها القضاة تفتقر إلى المعلومات الكافية للاستدلال على أصحابها، ما يضطر دائرة التنفيذ القضائي في مديرية الأمن العام إلى تصنيفها ضمن خانة "نظام اللا قيد"، أي أنها غير قابلة للتنفيذ.
وأكدت الدراسة وجود حالة من عدم الانسجام بين تبعية دائرة التنفيذ القضائي إدارياً للأمن العام، وبين واجباتها الوظيفية أمام المحاكم والنائب العام.
ورأت ان التدخل في عمل القضاء، وحرمانه من الممارسة الكاملة لاستقلاليته التي كفلها له الدستور، يضعف ثقة المواطنين بمرفق العدالة، وتعزيز الجنوح نحو إمكانية التحايل على القانون، والتشجيع على البحث عن وسائل غير قانونية لتحصيل الحقوق، وبخاصة في ظل ضعف الثقافة القانونية وثقافة التقاضي لدى المواطن.
وأشارت الدراسة الى وجود تفاوت كبير أحياناً بين القرارات القضائية في النوع نفسه من القضايا، نتيجة التدخل في إجراءات وقرارات التقاضي، وهو ما يؤذي صورة القضاء، ويضعف ثقة المواطن في الاعتماد عليه لتحصيل الحقوق.
وخلصت الدراسة الى ان بعض التشريعات ذات الصلة بالجريمة لم تعد تواكب التطور، وان العقوبات التي تنص عليها لم تعد رادعة، أو تحقق وظيفتها الوقائية.
وفي هذا السياق، اوصت الدراسة بضرورة زيادة عدد هيئات محكمة الجنايات الكبرى، وتوزيعها على الأقاليم، والالتزام بعدم تجاوز إجراءات التقاضي في محكمة الجنايات الكبرى في قضايا القتل العمد مدة سنة.
وأوصت بالإسراع بتنفيذ برنامج الإصلاح القضائي، بما من شأنه تحسين إجراءات المحاكم وتسريعها، وضمان الشفافية في عمل القضاء، وذلك في إطار احترام وحماية استقلال الجهاز القضائي، وتوفير كل أشكال الدعم له.
ودعت الى تشغيل نظام السجل العدلي الجديد، بهدف توفير السيرة العدلية الجرمية والحقوقية لاستخدامها عند اللزوم، وفي المحاكم أثناء النظر في القضايا، فضلا عن إعادة النظر في آليات التكفيل للمتهمين، بحيث تتضمن مراجعة وتدقيق السجل العدلي الجرمي، لاتخاذ القرار الذي يوازن بين حق المتهم وبين المصلحة العامة.
وبينت الدراسة ان السعي الى التوفيق بين النصوص الواردة في قانون العقوبات وقانون أصول المحاكم، وقانون منع الجرائم، سيكفل إزالة أي تعارض بينها، داعية الى اهمية سن تشريع يضمن للمواطن المطالبة بحقه في التعويض عن الأحكام والعقوبات الصادرة بحقه، والمشوبة بالتعسف في تطبيق القانون.
ووجدت الدراسة ضرورة تفعيل اختصاص محكمة العدل العليا بالحكم بالتعويض في القضايا الإدارية، وإيجاد مكتب فني قضائي تابع لمحكمة التمييز، لمراجعة القرارات القضائية لتجاوز الفروقات في الاجتهاد وخلق أداة رقابة.
ومن أجل تسريع إجراءات التقاضي، رأت الدراسة ضرورة فصل جهاز التنفيذ القضائي إدارياً عن الأمن العام، وإلحاقه بالقضاء، بهدف فصل الجانب القضائي عن الأمني، وتسريع إجراءات التقاضي.
ودعت الى تنظيم عقد هيئات استئناف في مراكز المحافظات حسب الحاجة وضغط العمل، بما يُسَرِّع إجراءات التقاضي ويخفف عن الأطراف ذات العلاقة، وتعديل قانون مراكز الإصلاح والتأهيل، بما يُؤَمِّن تعيين قضاة لتنفيذ العقوبات في السجون ومراكز الإصلاح.
وبينت اهمية إنشاء مركز يعنى بدراسات الجريمة وتحليل ظاهرة العنف الاجتماعي، يكون مركزه في إحدى الجامعات الرسمية، فضلا عن إنشاء مؤسسة اجتماعية أهلية تعمل بالتعاون مع وزارتي العدل والتنمية الاجتماعية، لتوفير الرعاية المناسبة لأسر السجناء ذوي الاحكام الطويلة، وكذلك المحكومين الذين قضوا مدة محكوميتهم، لدمجهم في المجتمع.
وشددت الدراسة على ضرورة مراعاة وضع أسس تعيين المدعين العامين، بحيث يكونون من أصحاب الخبرات القضائية الكافية، ووضع وتطبيق عقوبات بديلة، بما فيها خدمة المجتمع لمرتكبي الجنح، لتخفيف الضغط على السجون، والمساهمة في خلق ثقافة ترسخ فكرة أن العقاب يهدف إلى التأديب والإصلاح وليس الانتقام.
الأجهزة الأمنية
وفيما يتعلق بعامل الاجهزة الامنية، طرحت الدراسة تساؤلات حول السماح بشيوع اقتناء أسلحة أتوماتيكية غير مرخصة عند وقوع تلك الأحداث.
واكدت أهمية اعتماد أسلوب المبادرة، للحيلولة دون وقوع الأحداث، بدلاً من اعتماد أُسلوب رد الفعل عليها بعد وقوعها، وهو ما يتطلب من المؤسسة الرسمية تطوير الاسلوب الاول وجعله جزءاً من عملية تدريب الحكام الإداريّين والمسؤولين الأمنيّين.
وبينت أن عدم المبادرة باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، يجعل احيانا الأجهزة الرسمية طرفاً عند تطور حوادث العنف بدلاً من أن تكون المرجعية التي تمسك بزمام الأمور، وتضبط إيقاع المشهد، فتنتج عن ذلك انطباعات متناقضة بين التساهل والتشدّد، والتي قد تُفَسَر من بعض الأطراف بإمكانية تجاوز القانون، الأمر الذي يخلق انطباعات معاكسة بالظلم لدى أطراف أخرى.
وأكدت الدراسة غياب أو ضعف التنسيق بين الأجهزة الأمنية نفسها، وبينها وبين المسؤولين الحكوميّين المدنيّين، بما يزيد الامور تعقيدا.
وفي إطار الجهد الوقائي في مواجهة تنامي الجريمة، يلجأ الحكام الإداريّون إلى قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954، الذي يعطيهم الحق بإحضار المشتبه به، لأخذ تعهد عليه بكفالة كفيل أو من دون ذلك، ويملكون صلاحية احتجاز المشتبه به، وهذه الممارسة العملية تقود إلى الاعتقال الإداري لأعداد كبيرة من أصحاب السوابق وغيرهم من الأشخاص الذين يصنفون على أنهم خطرون على الأمن العام، ما يخلق أعباء إضافية على السجون، ويعزز مطالبات متنامية بإلغاء هذا القانون أو تعديله، بحيث تُحصَر صلاحية الاعتقال الاحترازي أو تقييد الحرية بالسلطة القضائية، بما يكفل عدم التوسع في الصلاحيات التقديرية للحاكم الإداري.
وفي هذا الجانب، خلصت الدراسة الى مجموعة من التوصيات، ابرزها تعديل قانون الأسلحة النارية والذخائر لسنة 1952، بهدف منع حمل السلاح منعا كاملا، وفرض مزيد من القيود على اقتنائه وحصره في أضيق نطاق، وتجريم حيازة السلاح الأتوماتيكي، وتغليظ عقوبة اقتنائه أو حمله أو الاتّجار به.
ودعت الى إعداد دليل للإجراءات الأمنية، لتنظيم العلاقة بين رجال الأمن والمواطنين، على أن يكون، مُعلَناً ومتاحاً للجميع، وإعادة صياغة قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954، في الاتجاه الذي يحافظ على وظيفته في منع الجريمة، مع الحفاظ على حقوق المواطن.
ودعت الدراسة الى اهمية الفصل التام بين صلاحيات المحاكم وصلاحيات الحكام الإداريّين، ومنع ازدواجية الملاحقة، والاخذ بصيغة "قاضي إدارة محلية" في كل محافظة، ليتولى تطبيق القانون، فضلا عن تحديد صلاحية الحاكم الإداري في القانون، بحيث لا تشمل القضايا الحقوقية.
وبينت الدراسة أهمية عدم الإفراط في استعمال القوة، من خلال وضع قواعد واضحة للاشتباك ملزمة لرجال الأمن،
مع ضرورة اتخاذ تدابير تأديبية صارمة بحق أي فرد من الأجهزة الأمنية يقوم بانتهاك القانون.
وأوصت بضرورة تنفيذ حملات أمنية من أجل سحب السلاح غير المرخص بعد فترة سماح بالترخيص، والتشدد في تطبيق العقوبات على مستخدمي الأسلحة الرسمية في المناسبات الاجتماعية.
الأعراف العشائرية
وبينت الدراسة أن المجتمع يتوسع في نطاق ممارسة العادات التي من شأنها فرض الاستقرار في مناطق وقوع العنف، ومنها عادة الجلوة والعطوة، غير ان تلك العادات اصبحت تشغل مساحة على حساب القانون المدني.
ورأت ان ممارسة هذه العادات ينبغي ان تكون في حدود ضيقة وفي مرحلة انتقالية، إلى أن يتم إنضاج الظروف المجتمعية والأمنية التي تسمح بطي صفحتها.
ودعت توصياتها في هذا الجانب، الى تشكيل لجنة اجتماعية في كل محافظة، برئاسة المحافظ، تنبثق عن المجلس الاستشاري، للتعامل مع القضايا التي تقع ضمن مجال تلك التعليمات، لاتخاذ الإجراءات التي تكفل تطبيقها، بما ينسجم مع القانون ويحافظ على الأمن والسلامة العامة، وإعطاء مضمون كتاب دولة رئيس الوزراء رقم 20/29/7/5083 بتاريخ 24 /4 /1987 صفة الإلزام، من خلال إصدار البنود الرئيسية فيه، كتعليمات ملزمة من قبل وزير الداخلية إلى الحكام الإداريين، بموجب نظام التقسيمات الإدارية، على أن تراجع تلك التعليمات بعد ثلاث إلى خمس سنوات، وبما يكرس تعزيز سيادة القانون (ملحق نص مضمون الكتاب).
المؤسسات التعليمية
ووجدت الدراسة بأن على المؤسسات التعليمية والجامعات واجبا تربويا، الى جانب وظيفتها التعليمية، نظرا لاحتضانها أعدادا كبيرة من الطلبة والمدرسين، الذين قد يشكلون حاضنة لإنتاج المشاكل الاجتماعية، وساحة لوقوع مواجهة بعد ان خيمت عليها الهويات الفرعية، وصنوف السلوكيات العصبوية.
ولفتت الدراسة الى أنه يتعين على تلك المؤسسات تأدية رسالتها التربوية والتنويرية، واعتبرتها اولوية وطنية لا يمكن تأجيلها فيما لو استمرت هيمنة الولاءات الفرعية على سلوكيات الطلبة، وسهولة استنفار العصبيات المختلفة لدى قطاعات واسعة منهم.
وبينت الدراسة بأن مشكلة العنف الجماعي في الجامعات غالبا لا تبقى محصورة في نطاق الحرم الجامعي، بل سرعان ما تنتقل المشاجرات داخل هذه المؤسسات إلى مواجهات أكثر عنفاً خارجها، وتعجز غالبا المؤسسات عن نزع فتيل الصدام فتصبح عبئاً على المجتمع بدل أن تكون عوناً له على تخطي مشاكله وتوتراته الاجتماعية.
ولفتت الدراسة الى ان الجامعات تعاني خللا مباشرا في أداء دورها على الصعيد الأكاديمي، فضلا عن طرق التدريس ومضمون المناهج وتنمية الشخصية المستقلة للطالب.
وأوردت الدراسة اسبابا إضافية تتصل بالبيئة العامة داخل الحرم الجامعي، في إشارة الى اوقات الفراغ الطويلة التي لا يشغلونها بالدراسة أو البحث، وهو ما يشير الى قلة البرامج والأنشطة اللامنهجية الجاذبة، التي تستوعب هواياتهم وطاقاتهم.
وأشارت الدراسة الى أن الانتخابات الطلابية التي تجرى داخل الجامعة تعيد إنتاج الولاءات الضيقة، بسبب غياب التنافس على أسس برامجية عامة، في إطار هوية وطنية جامعة، ولهذا تشهد الانتخابات، في العادة، احتكاكات ومواجهات على خلفية التنافس بين الهويات الفرعية.
وذهبت الدراسة الى ان تفاقم مظاهر العنف في الجامعة والمدرسة والملعب والحي، يعود إلى تراجع في دور الأسر والمدارس في ممارسة مسؤولياتها في تنشئة الأجيال الشابة.
وفي إطار المنهاج المدرسي، أكدت الدراسة الاهتمام بحصص الرياضة والفن، التي غالبا ما تهمش فتشتت طاقات الافراد بدلا من ان تشذب سلوكهم، وتثير ميولهم الإبداعية، كما اشارت الى غياب مواد، مثل تاريخ الفكر الإنساني من المناهج، على الرغم من اهميتها في فتح آفاق الطلبة وتشجيعهم على التفكير والتحليل.
ولفتت الدراسة الى اهمية دور المعلم في زرع القيم الإيجابية لدى الطلبة، وفي مجمل العملية التعليمية والتربوية، مشيرة الى ان الطالب والمعلم يشتركان في المعاناة من طبيعة المناهج وتضخمها، ما يساهم في حصر دور المدرسة في البعد التلقيني، ويحرمها من دورها التربوي.
وفي هذا الجانب، أوصت الدراسة بأهمية استعادة مكانة مهنة التعليم في المجتمع، من خلال تحسين الظروف الوظيفية للمعلم، وتوفير الفرص الكافية لتأهيله وتطوير قدراته.
وأكدت الدراسة اهمية تمكين المعلم من التنظيم، وفق إطار قانوني مناسب، وبما يكفل إدامة العملية التعليمية، وعدم إعاقتها، وبما يضمن رفع السوية المهنية في هذا القطاع الحيوي.
وأوصت بإقامة مركز وطني مهمته إعداد وتأهيل المعلمين قبل إلحاقهم بالمدارس، وكذلك توفير التدريب اللازم لهم في مراحل محددة من تقدمهم المهني، فضلا عن مراجعة المناهج بهدف تخليصها من الأعباء الكمية غير المجدية أو غير الضرورية، وتطويرها.
وأكدت الدراسة على الارتقاء بطرق وأساليب التدريس، بما يساعد في تنمية شخصية الطالب وقدراته على التفكير والتحليل، واعتماد اختبار لقياس المعيار الوطني للتحصيل المدرسي في اللغة والعلوم والرياضيات.
ودعت الى اعادة الاعتبار لحصص الرياضة والفن، واحتساب معدلاتها لتحسين مكانتها لدى الطلبة، وتنظيم مسابقات سنوية وطنية للطلبة، سواء في المجالات المعرفية أو الرياضية.
وشددت على ضرورة تفعيل دور المرشد التربوي، بصفته حلقة وصل بين الطالب والمعلم والأسرة، ورفد المدارس خارج العاصمة ومراكز المحافظات الكبرى بالكوادر التعليمية ذات الخبرة والتأهيل، وبشكل خاص في المجالات العلمية.
وفيما يتعلق بالتعليم الجامعي، دعت الدراسة الى مراجعة سياسات القبول في الجامعات، بحيث تستند إلى أسس المنافسة العامة والقدرة على التحصيل العلمي.
وأشارت الى اهمية جعل القبول في الجامعات على المستوى الوطني، بما لا يحصر قبول الطلبة في محافظاتهم، ويساهم في جعل الجامعات مؤسسات للاندماج وبناء الشخصية الوطنية للطالب، واعتماد برامج توجيه إلزامية عند دخول الطلبة إلى الجامعات، علاوة على تضمين المتطلبات العامة مواد للتربية الوطنية والثقافة المدنية والقانونية، بما فيها حقوق الإنسان، وذلك لتعزيز الهوية الوطنية.
وبينت الدراسة اهمية إعادة صياغة دور عمادات شؤون الطلبة بصورة تعطيها دوراً حقيقياً لإحياء البيئة الجامعية، من خلال تخطيط وتنفيذ فعاليات لامنهجية توجه وتطور طاقات الطلبة، وتبني شخصياتهم وثقافاتهم، فضلا عن تطوير أساليب التدريس الجامعي، بعيداً عن التلقين والروتين، وبما ينمي القدرات التحليلية والبحثية للطالب.
ودعت الجامعات الى تنظيم برامج تبادل دراسي وثقافي لطلبتها وأساتذتها مع الجامعات العالمية، بما يتيح لهم التفاعل مع مجتمعات جامعية متقدمة، اضافة الى بناء شراكات بين إدارات الجامعات والمجالس والاتحادات الطلابية، بحيث يتولى الطلبة مسؤولية إدارة بعض المرافق المخصصة لأنشطتهم.
وشددت على ضرورة وضع آليات واضحة يمكن ضبطها لمنع تفشي الواسطة والمحسوبية في العملية التعليمية، فيما يتعلق بالامتحانات والتقييم، واعتماد معايير ملزمة لقواعد سلوك الطلبة، لمنع استخدام العنف وخرق القانون.
الشــباب
وجدت الدراسة أن العوامل والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، في مجملها، ساهمت في إيجاد أرضية خصبة لنمو نزعة العنف لدى الشباب الذي يعاني، بطبيعة الحال، من صعوبات الحياة، ومن القلق نتيجة عدم وضوح الرؤية للمستقبل.
وأشارت الى ان أحد تجليات النزعة، هو بروز ظاهرة الشغب والعنف في الملاعب، والتي تعد أحد أوجه العنف المجتمعي، الذي غالباً ما يستدعي العصبيات والهويات الفرعية، ويسيء إلى الوحدة الوطنية.
وبينت الدراسة ان المجتمع الاردني يعد مجتمعاً شاباً، حيث تبلغ نسبة الشباب حوالي 70 في المائة من عدد السكان، وأنه على الرغم من أهمية هذه الميزة، إلا أنها تضع ضغوطاً هائلة على الدولة والاقتصاد الوطني، لتوفير التعليم وفرص العمل لهم.
ولفتت الدراسة الى اهمية وضع التنمية البشرية على اعلى قائمة الاولويات الوطنية، وهو ما يتطلب وجود وزارة تعنى بقضايا الشباب وتوصل صوتهم إلى دائرة صنع القرار.
ودعت الدراسة الى اعتماد خدمة العلم كآلية لتحقيق الاندماج والصهر الوطنيين، وتكريس قيم المساواة والمنافسة، والعمل والانجاز، ونبذ قيم مريضة، والحيلولة دون تفشيها في اوساط المجتمع، مثل الواسطة والمحسوبية.
وفي هذا الجانب، أوصت الدراسة بضرورة اقرار صيغة مناسبة لخدمة العلم لمدة سنة دراسية، تتوزع بين التدريب العسكري والتدريب على أعمال مهنية، وخدمة المجتمع، بهدف إيجاد آلية فعالة للاندماج بين الشباب، وترسيخ قيم المساواة والانتماء الوطني والانضباط بينهم.
ودعت الى ضرورة وجود وزارة خاصة بالشباب، لوضع قضاياهم وأولوياتهم أمام مجلس الوزراء، واقترحت تحويل وزارة الثقافة إلى وزارة للثقافة والشباب.
وأشارت الى ضرورة زيادة برامج التمويل الميَّسر، وتوجيهها إلى الشباب لمساعدتهم في إيجاد مشاريع صغيرة ومولدة للدخل في مختلف المجالات، بدلاً من انتظار فرص عمل يحتاج الحصول عليها في أحيان كثيرة إلى فترات طويلة.
وأوصت بتنظيم برامج خدمية وثقافية موجهة للشباب، وإتاحة المرافق اللازمة كالملاعب والمراكز الثقافية والعلمية والأندية، وإيجاد منابر وطنية للاستماع لمشاكل الشباب ونقلها إلى صناع القرار، لصياغة السياسات المناسبة لمعالجتها.
دور المؤسسات المجتمعية
حملت الدراسة المؤسسات المجتمعية مسؤولية مواجهة ظاهرة عدم الالتزام بسيادة القانون، مشددة على أهمية قيامها بمهام تعزيز منظومة الضبط في المجتمع، والتي يمكن ان تساهم في تطويق المشاكل قبل استفحالها. وبينت الدراسة ان جملة التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي شهدها المجتمع في العقود الأخيرة، ادت الى تراجع مكانة النخب التقليدية، ما ساهم في تغييب دور الحلقات الوسيطة وإضعاف تأثيرها كمنظومة ضبط.
ولفتت الى أنه، مع تطور المجتمع وانتقاله من حالة الى اخرى، يصبح لزاما على المجتمع المدني اثبات حضوره، لخلق الحلقات الوسيطة التي تشكل صمام أمان للمجتمع.
وأوصت الدراسة، في هذا السياق، بضرورة تشجيع منظمات المجتمع المدني على تأدية واجباتها في إشاعة ثقافة احترام الآخر، ومناهضة التجاوز على سيادة القانون والعنف، بمختلف أشكاله، واستنهاض مشاركتها في جهود رأب الصدع بين فئات المجتمع المتنازعة، في ظل الالتزام بالقوانين المرعية.
وأكدت أهمية تفعيل دور الخطاب الديني التسامحي في تعزيز منظومة الأمن الشامل في المجتمع، على سائر المسارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وذهبت الدراسة الى ان الإعلام، وبخاصة المحطات الفضائية والمواقع الإلكترونية، ساهم في نمو التوترات المجتمعية، وخلق حالة من عدم اليقين.
وأوصت في هذا السياق، بضرورة استثمار دور الإعلام والاتصال، لخلق ثقافة وطنية تعزز الالتزام بسيادة القانون، بما يوفر الأمان للمواطن والأمن للوطن، من خلال الانفتاح على الإعلام، والتعامل الإيجابي معه.
وشددت الدراسة على اهمية تطوير قدرات مؤسسية لدى الجهات المعنية بإنفاذ القانون، تمكنها من إعطاء معلومات دقيقة حول ما يقع من أحداث، بما لا يترك مجالا لترويج الإشاعات التي تفاقم تلك الأحداث وتزيد التوتر بسببها.
وبينت أن على وسائل الإعلام الالتزام بدور إيحابي فيما يتعلق بسيادة القانون والالتزام به، وألا تكون الإثارة دافعاً أساسياً في إبراز
التوترات المجتمعية
ودعت نقابة الصحفيين الأردنيين إلى عقد ملتقى وطني للإعلام، لدراسة المسؤولية الأدبية للصحافة ووسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية، لتكون جزءا من الجهد الوطني لإشاعة ثقافة سيادة القانون ومكافحة العنف.
ولم تغفل الدراسة عن دور المساجد على الصعيد الاجتماعي، إذ أوصت بتفعيل دور الخطاب الديني التسامحي في تعزيز منظومة الأمن الشامل، ودوره في السياسات الوقائية التي ترمي إلى نزع مكامن العنف والغلو والتطرف في التعامل مع الخلافات والصراعات.
سلافة الخطيب / الغد