 اشتعال مركبة بخلدا وبطولة مواطن تحول دون وقوع كارثة
اشتعال مركبة بخلدا وبطولة مواطن تحول دون وقوع كارثة
 قرار حكومي جديد حول ضريبة السيَّارات الكهربائيَّة
قرار حكومي جديد حول ضريبة السيَّارات الكهربائيَّة
 أول تعليق لإردوغان على مذكرة الجنائية الدولية لاعتقال نتانياهو
أول تعليق لإردوغان على مذكرة الجنائية الدولية لاعتقال نتانياهو
 المرصد العمالي: الحد الأدنى للأجور لا يغطي احتياجات أساسية للعاملين وأسرهم
المرصد العمالي: الحد الأدنى للأجور لا يغطي احتياجات أساسية للعاملين وأسرهم
 الديوان الملكي: الأردن يوظف إمكانياته لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان
الديوان الملكي: الأردن يوظف إمكانياته لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان
 ترمب يرشح الطبيبة الأردنية جانيت نشيوات لمنصب جراح عام الولايات المتحدة
ترمب يرشح الطبيبة الأردنية جانيت نشيوات لمنصب جراح عام الولايات المتحدة
 تفاصيل جريمة المفرق .. امرأة تشترك بقتل زوجها بعد أن فكّر بالزواج عليها
تفاصيل جريمة المفرق .. امرأة تشترك بقتل زوجها بعد أن فكّر بالزواج عليها
 الأردنيون على موعد مع عطلة رسمية قريبا
الأردنيون على موعد مع عطلة رسمية قريبا
 الإبادة تشتد على غزة وشمالها .. عشرات ومستشفى كمال عدوان تحت التدمير
الإبادة تشتد على غزة وشمالها .. عشرات ومستشفى كمال عدوان تحت التدمير
 ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 44.176 شهيدا
ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 44.176 شهيدا
 الأردن .. تشكيلات إدارية بوزارة التربية - أسماء
الأردن .. تشكيلات إدارية بوزارة التربية - أسماء
 السعايدة: انتهاء استبدال العدادات التقليدية بالذكية نهاية 2025
السعايدة: انتهاء استبدال العدادات التقليدية بالذكية نهاية 2025
 زين تنظّم بطولتها للبادل بمشاركة 56 لاعباً ضمن 28 فريق
زين تنظّم بطولتها للبادل بمشاركة 56 لاعباً ضمن 28 فريق
 وزير الزراعة يطلع على تجهيزات مهرجان الزيتون الوطني الـ24
وزير الزراعة يطلع على تجهيزات مهرجان الزيتون الوطني الـ24
 المملكة على موعد مع الأمطار وبرودة ملموسة وهبات رياح قوية يومي الأحد والإثنين
المملكة على موعد مع الأمطار وبرودة ملموسة وهبات رياح قوية يومي الأحد والإثنين
 مذكرة نيابية تطالب الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور
مذكرة نيابية تطالب الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور
 الأردن .. 3 سنوات سجن لشخص رشق طالبات مدارس بالدهان بعمان
الأردن .. 3 سنوات سجن لشخص رشق طالبات مدارس بالدهان بعمان
 اعلان صادر عن ادارة ترخيص السواقين والمركبات.
اعلان صادر عن ادارة ترخيص السواقين والمركبات.
 أوروبا "مستعدة للرد" في حال حدوث توترات تجارية جديدة مع واشنطن
أوروبا "مستعدة للرد" في حال حدوث توترات تجارية جديدة مع واشنطن

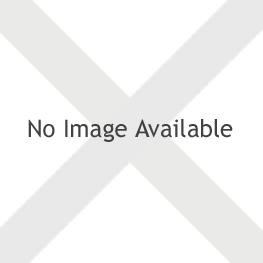
اشتبكت حيناً من الدهر مع بعض الملاحدة وغير المسلمين في عالم الغرب في سلسلة من الجدالات والحوارات حول الإسلام، فكانت النقطة الأساسية التي يبنون عليها هجومهم على ديننا القيّم تتركز في عدم التمييز بينه وبين المسلمين، معتبرين أن كل حماقة يأتي بها شخص يسمي نفسه مسلماً مردها إلى الإسلام ذاته. كنت في تلك النقاشات أؤكد دائماً أن هناك فرقاً شاسعاً وجذرياً بين الإسلام من جانب، وبين من يزعمون الانتماء إليه من جانب آخر، فليس بالضرورة أن يمثل هؤلاء مهما كثروا، ومهما علت أصوات تباكيهم على الإسلام، تعبيراً صادقاً وأميناً عن الدين، بل إنهم قد يسيؤون إليه بفهمهم الخاطئ له وافتراضهم أنهم يمثلونه خير تمثيل، وهو في واقع الأمر مما يزعمون من تجسيده والتعبير عنه براء.
أجدني أستعيد تلك الأفكار كثيراً هذه الأيام وأنا أشهد انفلاتاً فوضوياً جامحاً على الساحة العربية في خطاب الكثيرين، الذين يتحدثون وكأنهم أصبحوا يجسدون التعبير البشري المتبلور عن أوطانهم، قلباً وقالباً، وكأن الإنسي الزائل والآني والنسبي غدا الوطن الباقي والدائم والمطلق، وفي هذا ما فيه من السطحية والفجاجة والمزاودة وتجاهل المنطق والحقيقة.
الوطن، وهذا ما يفترض أن يكون واضحاً للجميع، هو أكبر وأدوم وأعظم من كل المنتمين إليه، ومن الذين يتنطعون للحديث باسمه وكأنهم أوصياء عليه، بحيث يدعون انفرادهم وحدهم بحبه والحرص على مصيره. إنه لكل أبنائه، صغارهم وكبارهم، ذكورهم وإناثهم، مهما تعددت واختلفت مشاربهم ومنابتهم وأفكارهم واتجاهاتهم واجتهاداتهم، وليس من حق أحد المزاودة على أحد فيه، وادعاء احتكار تمثيله أو فهم مصلحته أو الحرقة عليه أكثر من غيره، وإلا دخلنا ـ ونحن في زمن يعج بأهل النفاق والارتزاق ـ في دوامة لا نهاية لها من المزاودات الفجة والادعاءات الفارغة المغرضة، التي قد تهدد السلم الأهلي والاستقرار المجتمعي بصورة عميقة وخطيرة.
يفترض أن يكون واضحاً تماماً، وهذه مسألة مبدئية محورية يجدر التشديد عليها، أن نقد سياسة هنا، أو قراراً هناك، لا يعني على الإطلاق نقد الوطن أو تجريحه أو التعريض به، فالوطن ليس تجميعاً آلياً بائساً لحزمة من السياسات والقرارات، هذه التي تمثل اجتهادات بشرية قد تصيب وقد تخطئ، وينبغي أن تظل دائماً قابلة للنقد والتدقيق والتعديل والتبديل. أما مماهاتها ومساواتها هي أو أصحابها بالوطن، ووضعها ووضعهم معه في سلة واحدة، فهو أمر في بالغ الخطورة والتضليل؛ إذ إن ذلك سيفضي ولا شك إلى تحصينها بهالة من الرمزية والقداسة التي تحول دون نقدها أو تحليلها، وتخيلوا معي أين يمكن أن ينتهي حال وطن لا يمكن نقد السياسات والقرارات فيه، خوفاً من اتهام المبادرين إلى ممارسة حقهم في النقد بالإساءة إلى الوطن نفسه.
وحرية النقد، التي تعد شرطاً أولياً ضرورياً لا غنى عنه لضمان تمكن أبناء الوطن من الالتفات إلى ما قد يكتنف تلك السياسات والقرارات من نقاط الضعف والتخبط والقصور، تمهيداً لمراجعتها وتصويبها، ليست في حقيقتها إلا شكلاً من أشكال حرية التعبير، وهذه الحرية ينبغي أن تظل متمتعة بأقصى درجات الإتاحة والتأمين والتيسير، بعيداً عن أي شكل من أشكال التهديد والترهيب ـ شريطة ألا تنزلق طبعاً إلى دائرة التشهير الشخصي المغرض والرخيص ـ وإلا تحول الوطن إلى مستنقع مخنوق آسن مذعور، لا يضم إلا حفنة من المنافقين الأفاقين الذين يتصيدون في الماء العكر.
سجن أصحاب الآراء السياسية المغايرة وملاحقتهم، حتى وإن كانت تلك الآراء في منتهى الشطط والجموح والاختلاف، لا يسهمان، حسب ما نرى فيما لا حصر له من التجارب والحالات، إلا في تحويلهم إلى ضحايا وأبطال يتقاطر عليهم الدعم ـ البريء والمغرض ـ من كل حدب وصوب. والأجدى والأولى بكل تأكيد، إذا ما كنا نؤمن حقاً بتهافت أفكارهم وهشاشتها وتعارضها مع مصلحة الوطن وأهله، إخضاعها على طاولة العلنية إلى النقاش والمحاججة والتفنيد، بكل موضوعية وشفافية ووضوح، بعيداً عن أجواء الاتهام والتخوين، وذلك بدلاً من اقتيادهم إلى أقبية الزنازين تحت رتل من الشتائم والوعيد بقطع ألسنتهم وفقئ أعينهم، وكأننا نعيش في رواية كابوسية تنتمي إلى زمن القمع الستاليني.
كم من السياسات أثبتت عقمها وحمقها وانسداد أفقها في هذه الدولة العربية أو تلك، أفترون أن من الحكمة أو المروءة أن يصمت العربي الشريف عن التنبيه إلى عواقب تلك السياسات ونقدها والتحذير من تداعياتها خشية أن يقال إنه ينال من سمعة وكرامة الدولة والوطن؟ ألا ترون أن هذا المنطق يشبه منطق ذاك الذي يترك الأوساخ في داره تتراكم تحت السجادة، حتى لا يطعن أحدهم في نظافة بيته، فإذا به يفاجأ ذات يوم بالحشرات المقززة تملأ المكان وسط انبعاث رائحة كريهة لا تطاق؟
إذا كان البعض ممن يسارعون إلى التشكيك في وطنية إخوتهم أصحاب الآراء السياسية المختلفة والمطالبة بقطع ألسنتهم بتهمة الخيانة العظمى يهتمون حقاً بسمعة الوطن وصورته واجتماع قلوب أبنائه على كلمة واحدة، فلتتوجه جهودهم للدعوة إلى تبني وتفعيل نظام ديمقراطي حقيقي. ففي مثل ذلك النظام، تعبر السياسات والقرارات التي تتخذها حكومات ومجالس نيابية منتخبة بعدالة ونزاهة عن رأي أغلبية المواطنين في معظم الحالات، وساعتها ربما يمكن بالفعل تجنب اعتماد سياسات وقرارات قد لا تحظى بشرعية دستورية أو شعبية، يغدو زج الناس في السجون الحل الأسهل والأنسب لإجبارهم هم وغيرهم على كتم رأيهم الصريح بشأنها. وفي مثل ذلك النظام أيضاً، يُحترم رأي الأقلية المعارضة بصورة جدية، فلا يتم ترويعها أو التنكيل بها أو محاصرتها؛ ما قد يدفعها إلى الاستقواء بجهات أجنبية أو اللجوء إلى التطرف والعنف للدفاع عن وجودها المطارد والمقموع.
وفي مثل ذلك النظام كذلك، لا يتم حتماً النظر إلى نقد السياسات والقرارات وأصحابها من المسؤولين كجريمة فظيعة يتم إدخالها قصراً وتعسفاً في إطار الخيانة العظمى للوطن، فاجتهادات الساسة التي قد لا تعبر إلا عن أصحابها، أصابت أم أخطأت، وبخاصة في الأنظمة غير الديمقراطية، لا ينبغي قطعاً نسبتها للوطن أو الزعم بأنها تمثله؛ وإلا فإننا نخاطر بتشويه اسم الوطن وتحميله جريرتها. والمثال الأمريكي القريب يمكن أن يحضر بقوة هنا، فالسياسات الخرقاء للإدارة الأمريكية السابقة أصابت سمعة الولايات المتحدة الأمريكية كلها في مقتل، إلا أن صوت العقل في كل مكان ظل يقول إن تلك السياسات تمثل الحزب الجمهوري فقط، ولا تمثل أمريكا كوطن، لذلك سرعان ما اختار أغلبية الأمريكيين إيصال الحزب الديمقراطي إلى سدة الحكم عبر انتخاب أوباما، بغض النظر عما بتنا نلمسه من خيبة أمل أمريكا والعالم بفعل السياسات المتعثرة لهذا الأخير.
وأخيراً، تؤكد علوم النفس والتربية والاجتماع أن المعلم الذي لا يعرف إلا لغة العصى والعقاب والتهديد للتعامل مع طلبته، دون أن يكون قادراً على محاورتهم أو معنياً بفهم وتفهم واستيعاب وجهات نظرهم، وحتى نزقهم ومشاكستهم، هو معلم بائس ومهزوز وضعيف. فهل تراها وصلت الرسالة إلى السادة الذين يزعمون الحديث باسم الوطن؟
د. خالد سليمان
sulimankhy@gmail.com