 الموافقة على مذكرتي تفاهم بين السياحة الأردنية وأثيوبيَّا وأذربيجان
الموافقة على مذكرتي تفاهم بين السياحة الأردنية وأثيوبيَّا وأذربيجان
 وزير الدفاع الإسرائيلي لنظيره الأميركي: سنواصل التحرك بحزم ضد حزب الله
وزير الدفاع الإسرائيلي لنظيره الأميركي: سنواصل التحرك بحزم ضد حزب الله
 تعديل أسس حفر الآبار الجوفيّة المالحة في وادي الأردن
تعديل أسس حفر الآبار الجوفيّة المالحة في وادي الأردن
 اختتام منافسات الجولة السابعة من دوري الدرجة الأولى للسيدات لكرة القدم
اختتام منافسات الجولة السابعة من دوري الدرجة الأولى للسيدات لكرة القدم
 ما هي تفاصيل قرار إعفاء السيارات الكهربائية بنسبة 50% من الضريبة الخاصة؟
ما هي تفاصيل قرار إعفاء السيارات الكهربائية بنسبة 50% من الضريبة الخاصة؟
 "غرب آسيا لكرة القدم" و"الجيل المبهر " توقعان اتفاقية تفاهم
"غرب آسيا لكرة القدم" و"الجيل المبهر " توقعان اتفاقية تفاهم
 عجلون: استكمال خطط التعامل مع الظروف الجوية خلال الشتاء
عجلون: استكمال خطط التعامل مع الظروف الجوية خلال الشتاء
 "الأغذية العالمي" يؤكد حاجته لتمويل بقيمة 16.9 مليار دولار
"الأغذية العالمي" يؤكد حاجته لتمويل بقيمة 16.9 مليار دولار
 مستوطنون يعتدون على فلسطينيين جنوب الخليل
مستوطنون يعتدون على فلسطينيين جنوب الخليل
 أمانة عمان تعلن حالة الطوارئ المتوسطة اعتبارا من صباح غد
أمانة عمان تعلن حالة الطوارئ المتوسطة اعتبارا من صباح غد
 أبو صعيليك : انتقل دور (الخدمة العامة) من التعيين إلى الرقابة
أبو صعيليك : انتقل دور (الخدمة العامة) من التعيين إلى الرقابة
 أكسيوس: ترمب فوجئ بوجود أسرى إسرائيليين أحياء
أكسيوس: ترمب فوجئ بوجود أسرى إسرائيليين أحياء
 ملامح إدارة ترامب الجديدة في البيت الأبيض
ملامح إدارة ترامب الجديدة في البيت الأبيض
 البستنجي: قرار إعفاء السيارات الكهربائية حل جزء من مشكلة المركبات العالقة في المنطقة الحرة
البستنجي: قرار إعفاء السيارات الكهربائية حل جزء من مشكلة المركبات العالقة في المنطقة الحرة
 ارتفاع الشهداء الصحفيين في غزة إلى 189
ارتفاع الشهداء الصحفيين في غزة إلى 189
 بالتفاصيل .. اهم قرارات مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم
بالتفاصيل .. اهم قرارات مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم
 الصحة اللبنانية: 24 شهيدا في غارات على البقاع
الصحة اللبنانية: 24 شهيدا في غارات على البقاع
 الأردن .. السماح للمستثمرين في مشاريع البترول بتقديم عروض دون مذكرات تفاهم
الأردن .. السماح للمستثمرين في مشاريع البترول بتقديم عروض دون مذكرات تفاهم
 كولومبيا والنرويج يلتزمان باعتقال نتنياهو
كولومبيا والنرويج يلتزمان باعتقال نتنياهو

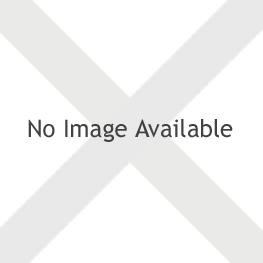
الاحتفال بالمولد النبوي يجب أن يأخذ طابعاً عملياً تطبيقياً
على العلماء والمفكرين والدعاة العمل للخروج من دائرة النفاق ودائرة المقت
الإلهي
مؤتمراتنا وندواتنا واحتفالاتنا تعاني من عيوب وعورات آن أوان التخلص منها
العمل من أجل الوحدة الإسلامية أوجب واجبات المسلمين في هذا العصر
بلال حسن التل
يحتل التاريخ أحد أهم مكونات بناء وعي الإنسان. لذلك حث القرآن الكريم في
الكثير من آياته, على التدبر في قصص الأولين وسيرهم, لأخذ العبر,
والاستفادة من التجربة. وقد دأبت الأمم الحية على إحياء الذكريات والأحداث
العظام في تاريخها, وسير عظمائها, للتعلم من هذه الذكريات والأحداث,
والتأسي بهؤلاء العظام, وتربية أجيالها على مآثرهم. فكيف إذا كانت هذه
الذكرى هي ذكرى مولد خاتم رسل الله. الذي ارتضاه ربه رسولاً للعالمين?.
وكيف إذا كانت السيرة سيرة رسول الله التي أمرنا من ربنا بالتأسي به
والاقتداء بهديه والسير عي نهجه?. وهي السيرة التي صارت أهم عامل أثر في
تاريخ البشرية منذ بُعث عليه السلام حتى يوم الناس هذا.
عندئذ لا يجوز ان يقتصر الاحتفال بذكرى مولد رسولنا عليه السلام على الخطب
الرنانة. التي لا يتجاوز تأثيرها منطقة السمع من المتلقي لها. فالاحتفال
برسول الله عليه السلام يعني أول ما يعني الاقتداء به والسير على نهجه,
والتمسك بسنته وعترته الطاهرة. وهذا كله لا يكون بمجرد الكلام. فالإسلام
ابتداءً هو دين العمل الذي يمقت الذين يقولون ما لا يفعلون, ففي القرآن
الكريم »كبر مقتاً عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون« وفي الأثر »رب قارئ
للقرآن والقرآن يلعنه«. وأول من يلعنهم القرآن هم أولئك الذين يقولون ما لا
يفعلون. ويظهرون ما لا يبطنون. وأولئك هم المنافقون الذين حذرنا منهم كتاب
الله وحديث نبيه.
ولأن الإسلام دين العمل, كان صحابة رسول الله عليهم رضوان الله أجمعين.
يحفظون الآيات العشرة من القرآن, لا يبرحونها إلى غيرها حتى يفقهوها
ويطبقوها في حياتهم. فقد فهموا من نبيهم أن دينهم دين الحياة; لذلك لا بد
من تطبيقه في كل مناحي حياتهم وشؤونها وفق ما جاء به كتاب الله وسنة رسوله.
لذلك كله, فإن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف, يجب أن يأخذ الطابع العملي
التطبيقي. وأول ذلك ان نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم ونسير على
نهجه, في كل مناحي حياتنا. وأولها ان نتمثل بأخلاقياته عليه السلام. فقد
كان خلقه القرآن, ولأنه بعث ليتم مكارم الأخلاق, كما قال عليه الصلاة
والسلام. وأول مكارم الأخلاق الصدق في القول والعمل من خلال تطابق ما نقوله
مع ما نفعله, حتى نخرج من زمرة المنافقين, ومن زمرة الذين يمقتهم خالقهم
لأنهم يقولون ما لا يفعلون. وعليه; فإن أول من يجب عليه الخروج من دائرة
المقت والنفاق هم العلماء والمفكرون والدعاة. وهذا الخروج لا يتم إلا إذا
توافق سلوكهم مع ما يقولون. وتحولت قرارات وتوصيات مؤتمراتهم إلى أفعال, من
خلال متابعة هذه القرارات والتوصيات لتنفيذها.
وهذا يستدعي أن ترتقي لقاءات المسلمين, ومؤتمراتهم وندواتهم, إلى مستوى
المسؤولية الملقاة علي عاتق العلماء والمفكرين والدعاة. وحتى يتم هذا
الارتقاء, فلا بد من ان تتخلص هذه اللقاءات والمؤتمرات والندوات من العيوب
والعورات التي تعتورها, والتي سبق وأن أشرت إلى بعضها في هذه الصحيفة
وأولها: أن هناك حالة من الفوضى التي تؤدي إلى التكرار في الموضوعات التي
تعالجها جل المؤتمرات والندوات, خاصة وأن هذا التكرار لا يعني التركيز على
معالجة الموضوعات التي تُناقَش, ولكنه تكرار ينم عن عدم جدية الجهات
المنظمة لهذه المؤتمرات, حيث يتم التعبير عن عدم الجدية بتكرار نفس الكلام
الذي يقال في جل هذه المؤتمرات. وفي كثير من الأحيان بين نفس الأشخاص الذين
يشاركون في هذا المؤتمر أو ذاك. وفي ظني أن من الأسباب الرئيسية لهذا
التكرار غياب التنسيق بين الجهات المنظمة لهذه المؤتمرات والندوات, علماً
بأن الكثير منها ترتبط ببعضها البعض, بروابط يجب ان تنعكس تنسيقاً وعملاً
مشتركاً ومن ثم تكاملاً في أنشطتها بدلاً من التكرار.
ومن مظاهر عدم الجدية التي تعانيها مؤتمراتنا أيضاً عدم التزام الجهات
المنظمة والمشاركين فيها بالوقت المخصص لبدء جلسات المؤتمرات أو نهايتها,
وكذلك عدم التزام المتحدثين والمناقشين بالوقت المخصص لكل منهم, بل وكثيراً
ما يغادر المشارك جلسات المؤتمر للجلوس في الردهات والغرف الجانبية, ما
يعطي انطباعا بعدم الاحترام وعدم الجدية في التعاطي مع الموضوعات المطروحة.
ثاني الملاحظات التي يخرج بها المرء من مشاركته ومتابعته لهذا النوع من
النشاطات الفكرية هي: غياب التمييز عند الكثير من الجهات المنظمة بين
المؤتمر والندوة وحلقة النقاش والمهرجان الخطابي.
فليس من المعقول أن تدعى إلى مؤتمر ثم تفاجأ بحضور بضعة الآف من المشاركين.
ففوق أن هذا العدد يحول بين المشاركين, وبين النقاش الجاد الذي يؤدي إلى
نتيجة حول الموضوع المطروح, فإنه أيضاً لا يمكّن من تحقيق تجانس في السوية
الفكرية للمشاركين, مما يفقد النقاش إن حصل جديته ومستواه الفكري, خاصة إذا
أنبرى لمناقشة الموضوع من يحدثك عن عذاب القبر تعقيباً على ورقة عن
التوازنات الاستراتيجية في المنطقة.
وليس من المعقول أن تُدعى إلى مؤتمر مدته يوم أو يومان, ثم تفاجأ بأن عدد
الأوراق التي ستناقش فيه تزيد عن المئتي ورقة, لم يسبق لأحد من المشاركين
ان أطلع على شيء منها ليناقشها. مما يحول دون تحقيق الفائدة, خاصة وأن
الكثير مما يسمى مؤتمرات, صار يفتقر إلى التخصص في قضية يعقد من أجلها,
فصار برنامجها يشتمل قضايا العالم كلها لتناقش في يوم أو يومين, لا يتاح
فيهما أكثر من دقائق معدودة أمام المشارك للإدلاء برأيه واستعراض بحثه, مما
يُذهب الجهود والأموال التي بذلت على هذا المؤتمر أو تلك الندوة أدراج
الرياح.
ملاحظة ثالثة يخرج بها المرء من مراقبته للمؤتمرات, التي تعقد حول قضايا
الإسلام والمسلمين وهي: أن هذه المؤتمرات تحولت من وسيلة إلى هدف, كشأن
الكثير من الوسائل في بلادنا التي تختل فيها الموازين والمفاهيم. فالأصل في
المؤتمر أن يعقد لمناقشة قضية بعينها. بهدف الوصول إلى تصور لحلها, ووضع
آليات للوصول إلى هذا الحل. ومن ثم متابعة تنفيذ القرارات أو التوصيات التي
يصل إليها المؤتمر. أي أن أهمية المؤتمر تنبع مما يليه من عمل وخطوات
تنفيذية. وهو ما لا يحدث في بلادنا. حيث ينتهي كل شيء مع إنتهاء الجلسة
الختامية للمؤتمر. والتي غالباً ما تتضمن كلاماً إنشائياً لا يسمن ولا يغني
من جوع. ولعل هذا من أسباب تكرار نفس التمنيات والكلام الإنشائي في جل
المؤتمرات التي تشهدها بلادنا. ومن يراجع البيانات الختامية والتوصيات
والقرارات التي تصدر عن المؤتمرات التي تعقد في بلادنا يجدها مكررة بصورة
أو بأخرى, بإستثناء كلمات قليلة في البيانات الختامية مع تغيير في تاريخ
الانعقاد. مما يعني أن شيئاً من الأهداف المعلنة لمثل هذه المؤتمرات لا
تتحقق. وأن الهدف الوحيد الذي صار لمثل هذه المؤتمرات هو تسجيل الحضور
الإعلامي للجهات المنظمة لهذه المؤتمرات. ولعل هذا يفسر حرص القائمين عليها
على إنجاح جلسات الافتتاح والحرص على حشد أكبر عدد من الحضور دون مراعاة
للمستوى الفكري والثقافي لهذا الحضور.
غير الحضور الإعلامي, الذي صار هدفاً وحيداً للكثير من المؤتمرات, فقد صار
الارتزاق هدفاً للكثير من الجهات التي تنظم هذه المؤتمرات والندوات, وقد
شكل هذا الهدف عند هذه الجهات مدخلاً رئيسياً للتمويل الأجنبي, الذي يقف
حتى وراء نشوء الكثير من هذه الجهات. لأنها صارت قناة رئيسية من قنوات هذا
التمويل لتحقيق أهدافها, في تدمير وعي الأمة, عبر تدمير منظومة قيمها
ومناهجها, واستبدالها بمنظومة قيم ومفاهيم جديدة. عبر اخضاع الكثير من
المسلّمات للنقاش, وعبر إثارة الشكوك والفتن التي من شأنها تمزيق البناء
الاجتماعي والأخلاقي والسياسي للمسلمين.
الملاحظة الهامة في هذا المجال, أن التمويل الاجنبي ينصرف إلى مجال القيم
والمفاهيم في بلادنا ويتجاهل المجال العلمي والتقني. حيث لا يتم تمويل
مؤتمرات ذات طبيعة علمية وتقنية في بلادنا إلا في حالات نادرة جداً جداً.
وهذا خلل يجب أن تتصدى له المؤسسات المالية في بلادنا لمعالجته من خلال
تمويل أنشطة في هذا المجال. بل والسعي للحلول محل التمويل الاجنبي في مجال
تمويل الأنشطة الفكرية ومنها المؤتمرات والندوات.
ملاحظة أخرى يمكن للمرء أن يخرج بها من متابعته لسيل المؤتمرات والندوات
ذات العلاقة بمنطقتنا وهي: أن هذه المؤتمرات في مجملها, تتصف أولاً
بالعمومية, وتفتقر الى التخصص. حيث يحدث أن تستمع في المؤتمر الواحد إلى
حديث عن تكنولوجيا غزو الفضاء, وإلى آخر عن النقد والشعر دون مراعاة
للأولويات والتخصصات.
وفوق العمومية وغياب التخصص; فإن جل هذه المؤتمرات تغرق في الحديث عن
الماضي, أو وصف الحاضر دون أن تحاول استشراف المستقبل. وهو الهدف الرئيسي
الذي يجب أن تعقد من أجله المؤتمرات. التي صارت تغرق عندنا بالخطاب الوصفي
والإنشائي وتفتقر إلى المعرفة والمعلوماتية. فصارت عاجزة عن إبداع واجتراح
الحلول للمشكلات التي نواجهها.
ملاحظة أخرى هامة وليست أخيرة, ومصدر أهميتها أنها ترتبط بالأخلاق والسلوك:
ذلك أن حالة واضحة من المجاملة والنفاق والتكاذب, تسيطر على أجواء الكثير
من المؤتمرات والندوات, تحول دون المصارحة والمكاشفة, لإصلاح أمرها, ومن ثم
إصلاح قدرتها على حل المشكلات التي تتصدى لحلها. فتحولت هذه المؤتمرات الى
مشكلة بدلاً من أن تكون أداة من أدوات الحل.
ان المؤتمرات والندوات في بلادنا تصلح كنموذج للتدليل على مدى الانفصام
النكد عند المسلمين بين القول والفعل. بخلاف المنطوق القرآني والحديث
النبوي اللذيْن يحثان على اقتران القول بالفعل. وهو مؤشر خطير, يقودنا إلى
الحديث عن آفة أخرى تعصف بالمسلمين, تلك هي حالة الانهيار الأخلاقي
والاجتماعي, التي تعاني منها بلاد المسلمين. والتي صارت أحد المنافذ
الرئيسية لأعدائهم, للتحكم بمصيرهم. وهذا الانهيار الأخلاقي والاجتماعي
دليل إتهام صارخ للدعاة والعلماء والمفكرين, بانهم قصروا. وما زالوا في
الحفاظ على المنظومة الأخلاقية والاجتماعية للمسلمين. يوم أنصرف جل هؤلاء
الدعاة والعلماء والمفكرين عن التربية الأخلاقية والاجتماعية الى التعاطي
بقشور السياسة اليومية. وفي هذا مخالفة صريحة للنهج النبوي. فقد أمضى رسول
الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والسلام جل سنوات الدعوة الأولى في
البناء الأخلاقي والنفسي لمن آمن به, وصدق دعوته, وظل هذا البناء محل
اهتمامه عليه السلام الى أنْ لقي وجه ربه راضياً مرضياً. فقد بُعث عليه
السلام ليتم مكارم الأخلاق. لذلك فإن المطلوب منا ونحن نحيي ذكرى مولده
الطاهر; أن نعيد الاهتمام بالأخلاق وبالبناء الاجتماعي إلى بؤرة
اهتماماتنا, وان يحتل رأس قائمة أولوياتنا.
إن المنظومة الأخلاقية التي بشر بها رسول الله عليه الصلاة والسلام, وربى
عليها آله وصحبه, ووصى بها أتباعه إلى يوم الدين, وهي وصفة العلاج الحقيقية
التي تقيل المسلمين في هذا العصر من كل عثراتهم. وأول ذلك انه عليه السلام
ربى المؤمنين به على خُلق الوحدة وجعل الخروج على وحدة المسلمين من
المحرَّمات, التي تستحق أقسى العقوبات. حتى ولو وصلت العقوبة إلى قتل
الخارج عن الصف المفرّق للجماعة. فهل يناقش أحد من مسلمي هذا العصر بأن
فرقة المسلمين من أهم أسباب ضعفهم وهوانهم. واستقواء أعدائهم عليهم.
واستباحتهم لأموالهم وأعراضهم??.
لقد صار العمل من أجل وحدة المسلمين. من أوجب واجبات المسلم في هذا العصر.
حتى يخرج المسلمون مما هم فيه من ضيق ومذلة ناجمة عن فرقتهم. وأول الخطوات
على طريق الوحدة ان يسد المسلمون الأبواب والنوافذ أمام كل دعوات الفتن
المذهبية والطائفية. التي يحاول أعداؤهم إغراقهم فيها, وهذا يفرض على
المسلمين ان يعوا ويفهموا عباداتهم ومغازيها. ذلك ان كل عبادة في الإسلام
تنبه المتعبد بها إلى أهمية وحدة المسلمين كأمة واحدة. فصلاة الجماعة أفضل
من سائر الصلوات, ومثل الصلاة كذلك الحج, والصيام. بل انه ما من شعيرة من
شعائر الإسلام تخلو من حث على الوحدة. فهل يفقه المسلمون معاني عباداتهم
ومغازي شعائرهم? انهم إن فهموا ذلك كانت الوحدة هدفهم ووسيلتهم في آن معاً.
ومثلما ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم آل بيته وصحابته على خلق الوحدة,
وأوصاهم بها; فقد رباهم على العزة, والرفعة, والمنعة, وعدم إِعطاء الدنيّة
في دينهم ودنياهم. وعدم المساومة على الحق وعدم القبول بأنصاف الحلول, إذا
تعلق الأمر بحد من حدود الله, أو بحق من حقوق عباده. وأولها: الحفاظ على
أرض المسلمين حرة, تحت راية الإسلام حتى إذا ديس شبر منها صار الجهاد فرض
عين على كل مسلم ومسلمة. وهل وصل المسلمون إلى ما هم فيه من هوان وفرقة إلا
لأنهم قبلوا الدنية وساوموا على حقوقهم حتى في أرضهم? وقد آن لهم أن
يعودوا إلى تعاليم نبيهم في رفض الدنيّة, ورفض أنصاف الحلول فهو القائل:
»والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما
تركته أبداً حتى أهلك دونه«. ومن هذا القول النبوي يجب أن يعلم المسلم, أن
أول ما يجب أن يتصف به هو التحدي والتصدي للباطل وللظلم, مهما كان نوعه
ومصدره. فتلك أول صفات المسلم الحق, وهذا أول دروس المدرسة المحمدية
المباركة.
ان العزة والرفعة والمنعة وعدم أعطاء الدنية في الدين والدنيا, وغيرها من
الصفات التي اتصف بها رسولنا عليه السلام, الذي أمرنا ربنا بأن نقتدي به
تعني أولَ ما تعنيه; ان يبني المسلمون مجتمعهم على العدل والمساواة. وأن
تكون الحرية قاعدته الأولى. فقد جاء رسول الله عليه الصلاة والسلام ليحطم
كل الطواغيت والأصنام ليعيش الناس أحراراً لا ينحنون, إلا لمن خلقهم ولا
ينساقون إلا للحق. وهذا أول ما يجب أن نتذكره في يوم مولد رسولنا عليه
السلام. وهو أول ما يجب أن نسعى إليه إذا أردنا أن نقتدى به إنفاذاً لأمر
الله لنا.
لقد بُعث رسول الله صلى الله عليه وسلم للعالمين. وجعلت أمته لتكون شاهدةً
على الناس. والشهادة تعني الحضور الواعي. وهذه حقيقة كبرى يجب أن يعيها
المسلمون ليتمكنوا من تحقيق عالمية دعوة نبيهم. وليؤدوا دور الشاهد على
البشرية. وهذا جزء من الأمانة التي تركها على عاتقهم رسولهم الذي يحتفلون
هذه الأيام بذكر مولده عليه السلام. فهل يؤدون الأمانة?.