 الأردن .. استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي وتحذيرات من السيول والبرد
الأردن .. استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي وتحذيرات من السيول والبرد
 مصدر أمني يكشف علم الأسد بهجمات "فلول" النظام المخلوع في الساحل السوري
مصدر أمني يكشف علم الأسد بهجمات "فلول" النظام المخلوع في الساحل السوري
 إيقاف 4 مسارات لباص عمان بعد الإفطار خلال رمضان – أسماء
إيقاف 4 مسارات لباص عمان بعد الإفطار خلال رمضان – أسماء
 التربية: عقوبة إشعال النار بطالب تصل الفصل من التعليم
التربية: عقوبة إشعال النار بطالب تصل الفصل من التعليم
 5 إصابات بحادث تدهور في الكرك
5 إصابات بحادث تدهور في الكرك
 الاردن يستضيف الأحد اجتماعاً لدول الجوار السوري
الاردن يستضيف الأحد اجتماعاً لدول الجوار السوري
 الملكة رانيا تقيم مائدة إفطار لعدد من سيدات العقبة
الملكة رانيا تقيم مائدة إفطار لعدد من سيدات العقبة
 شهيد وإصابات في الشجاعية بقصف للاحتلال .. كم بلغت إحصائية العدوان؟
شهيد وإصابات في الشجاعية بقصف للاحتلال .. كم بلغت إحصائية العدوان؟
 عاصم منصور يرد على مقولة ( السرطان ليس مرضا)
عاصم منصور يرد على مقولة ( السرطان ليس مرضا)
 الخارجية تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف منشأة أمنية في الباكستان
الخارجية تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف منشأة أمنية في الباكستان
 الأرصاد تحذر .. هطولات مطرية غزيرة وبرد في عدة محافظات
الأرصاد تحذر .. هطولات مطرية غزيرة وبرد في عدة محافظات
 السلطات السورية تعتقل رئيس مخابرات حافظ الاسد (إبراهيم حويجة)
السلطات السورية تعتقل رئيس مخابرات حافظ الاسد (إبراهيم حويجة)
 الأردن .. وفاة عشرينية بانهيار سقف منزل بالشونة الشمالية
الأردن .. وفاة عشرينية بانهيار سقف منزل بالشونة الشمالية
 تحرير 6 مخالفات لمنشآت تجارية وإزالة 25 بسطة في إربد
تحرير 6 مخالفات لمنشآت تجارية وإزالة 25 بسطة في إربد
 15 قتيلا من الأمن السوري بكمائن مسلحة لفلول النظام بريف اللاذقية
15 قتيلا من الأمن السوري بكمائن مسلحة لفلول النظام بريف اللاذقية
 مؤسسة الإقراض الزراعي بمحافظة إربد تمنح قروضاً بدون فوائد لمربي الثروة الحيوانية
مؤسسة الإقراض الزراعي بمحافظة إربد تمنح قروضاً بدون فوائد لمربي الثروة الحيوانية
 بريطانيا: نحو 20 دولة قد تنضم إلى التحالف بشأن أوكرانيا
بريطانيا: نحو 20 دولة قد تنضم إلى التحالف بشأن أوكرانيا
 تحرير 6 مخالفات لمنشآت تجارية وإزالة 25 بسطة في محافظة اربد
تحرير 6 مخالفات لمنشآت تجارية وإزالة 25 بسطة في محافظة اربد
 الحنيفات للرواشدة: استيراد البطيخ السعودي لأيام محدودة فقط
الحنيفات للرواشدة: استيراد البطيخ السعودي لأيام محدودة فقط

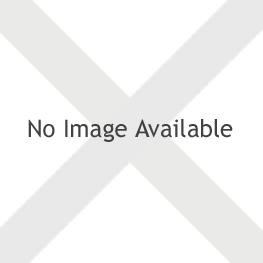
هذا سؤال أضعه بين يدي الجميع (هنا)؛ بهدف إعادة التفكير في معنى هذه المناسبات ومضامينها الحقيقية، في ظل الابتذال والتفريغ والشكلية التي يتم التعامل معها اليوم.
ليس المقصود بالطبع حرمان الناس من التفيؤ بأي ظلال عطرة والاحتماء بها من الظروف العصيبة، وتلمّس ما فيها من نفحات روحية تعيد إحياء الروابط وتجديد المشاعر بين الإنسان ودينه وحضارته، ومكامن هويته التي تضيع بوصلتها في الواقع المعاصر.
فهذا أضعف الإيمان، وباب من أبواب الدعوة والخير، لكن المطلوب هنا البحث عن المفتاح الصحيح لهذا الباب والطريقة الصحيحة لولوجه، حتى يكون فعلاً باباً للخير والتغيير والإصلاح والنهوض، لا لتسكين المشاعر وتخدير الناس والخروج بهذه المناسبات عن غاياتها وأهدافها.
داعي هذا الحديث أنّ إحياء المناسبات التاريخية ذات الدلالة الدينية اتخذ خلال العقود الأخيرة طابعاً محزناً، في الإدراك الشعبي والوعي المجتمعي، معاكساً تماماً لفلسفة الحدث والعبرة منه، بل أصبحت صيغة الاحتفالات ومضمونها بمثابة دلالة بازغة واضحة قطعية على أنّنا حتى ونحن نحتفل بالمناسبات الدينية فإنّنا نمارس ما يعاكسها ويضادها.
هل يعقل أن تختزل ذكرى ميلاد الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلّم) وما تحمله من مضامين كبيرة إلى طقوس من التمتمات والأناشيد لدى غالبية الناس، ثم ينصرفون إلى واقعهم الذي يناقض تماماً ما جاء من أجله وولد له هذا الرسول(صلى الله عليه وسلّم)، وهم يظنون أنّهم ناصروه وانتصروا له، وإنّما هم في الواقع انقلبوا على مقاصد رسالته وأهدافها!
بذلك، تكون العودة إلى ذكرى ميلاد الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلّم) مناسبة لاستشعار دلالات الحدث والتحولات التي أحدثها في مسار البشرية، وقبل ذلك لدى "العرب" من حملوا هذه الرسالة وتماهوا معها منذ القرن السادس الميلادي.
ميلاد الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم) كان إيذاناً ومؤشراً أوّلياً بانبثاق رسالة الإسلام إلى العالم، وإحداث أحد أكبر الانقلابات في تاريخ البشرية، ونشوء واقع جديد بالكلية، يعكس تغيراً كاملاً في حياة ملايين البشر بعد ذلك، وولادة أمة إسلامية تنتمي في عقائدها ومشاعرها وشرائعها لهذا الدين.
منذ تلك اللحظات أصبحت الجماعة المسلمة التي بدأت بفرد، ثم عدد قليل، فدولة صغيرة، "رقماً صعباً" في تاريخ البشرية وتطور الإنسان إلى اليوم، الدلالة هنا بالتأكيد ليست سياسية (محدودة) بل دينية، إنسانية، علمية، اجتماعية، ثقافية، تاريخية.
ذلك أنّ الأمة المسلمة ليست "معادلة سياسية"، إنّما هي مجتمعات وثقافات ولغات وتاريخ، وقبل ذلك عقائد ومشاعر وشعائر وتشريعات وتراث كبير ممتد. وتلك هي أحد مخرجات ولادة الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلّم).
بالضرورة، لم يكن المسار التاريخي منتظماً منذ ولادة الدعوة الإسلامية، فهو بين صعود وهبوط. البعض يؤرخ لوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وما حمله من بذور اختلاف بين الصحابة حول هوية القيادة الجديدة، ومن ثم حروب الردة، كبداية للانكسار. البعض الآخر يعتبر نقطة التحول ابتداءً من مقتل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهنالك من يبدأ منذ الفتنة الكبرى، ومعركة صفّين، وآخرون يتجاوزون ذلك بوصفه خلافات داخلية طبيعية، لم تؤثر حينها على هيبة الدولة والأمة، ويبدأون مسار الانحطاط والتراجع منذ العصر العباسي الثاني، وإعادة تموضع مراكز القوى وتحولها من "مركز الخليفة" إلى "إمارة التغلب" التي بدأت مع البويهيين والسلاجقة ثم الأيوبيين والمماليك.
ما يعنينا هنا: أنّ في كل تلك المراحل والتحولات والانقلابات والاهتزازات التي مرّت بها الشعوب والمجتمعات المسلمة كانت هنالك لحظات تحدث "اختراقاً" في الواقع، وتعيد إنتاج الوعي العام باتجاه اختطاف المبادرة والاستجابة للتحدي، والعودة مرّة أخرى إلى الإمساك بالمسار التاريخي، وتحويل الهزيمة بأيّ معنىً كانت إلى انتصار وفوز.
هذا "الاختراق" هو نقطة البداية في التغيير الذي نطمح إليه اليوم وصولاً إلى الخروج من الواقع الحالي. صحيح أنّ المخرجات لا بد أن تكون عسكرية وسياسية تنعكس على استعادة الأمة لوضعها واستعادة تماسّها مع رسالتها، لكن البداية بالضرورة تنبع من وعي الأمة وثقافتها وإدراكها لحجم الخطر والتهديد.
في سياق عملية الاختراق والخروج من الواقع، فإنّ دور القيادة السياسية أو الدينية يكمن في وضع عجلة الوعي على مسارها الصحيح، لكن هنالك عملا مهما دائما على الجانب المعرفي والثقافي يسبق ذلك ويحضِّر له، وهو عمل تقع مسؤوليته الرئيسة، في الأغلب، على عاتق الفقهاء والعلماء الذين يعملون على "البنية التحتية" التي تصنع التغيير.
أذكّر هنا بكتاب ماجد عرسان الكيلاني "هكذا ظهر جيل صلاح الدين وهكذا عادت القدس"، وهو يحيل إلى الأثر الذي تركته المدارس النظامية ودور الغزالي وتهيئة الجيل الإسلامي الذي حمل راية التغيير، بعد أن توغّل الصليبيون...
مشروع الغزالي الإصلاحي- الفكري، الذي تؤول إليه تحولاته وإنتاجه المعرفي والفكري خصوصا مع كتابه "إحياء علوم الدين" الذي يبرز فيه تركيزه على ما آلت إليه أحوال العلماء والفقهاء، وما نجم عن ذلك من تدهور في الحالة العامة، اجتماعياً وسياسياً.
أظن، وليس أغلب الظن بإثم، أنّ "باب العلم" تحديداً، في الإحياء، ما يزال مهماً وحيوياً إلى اليوم، تجدر دراسته وتدريسه؛ لما فيه من تحليل رائع لترابط العوامل النفسية والاجتماعية والسياسية، وارتباطها بوضع العلماء والفقهاء ودورهم، هو أقرب إلى قراءة تفكيكية نقدية ممتازة لمجتمع "علماء الدين".
"الاختراق" أحدثه أيضاً عدد كبير من الفقهاء، منهم ابن تيمية والعز بن عبد السلام في مواجهة الغزو التتري، ووقف وراء بروز قيادات سياسية وعسكرية كبيرة في التاريخ قامات فقهية من علماء الشرع عملت على جبهات متعددة، في التجديد الفقهي والديني، وترسيم استراتيجيات المواجهة المعرفية للتحديات والتهديدات التي تمرّ بها الأمة المسلمة، وعلى جبهة التعليم تخريج أجيال تحمل مشاعل التغيير والإصلاح، وعلى جبهة الإصلاح السياسي والاجتماعي والثقافي...
ذلك الاستخلاص يعيدنا إلى ما بدأنا به هذا المقال في التساؤل عن منطق الاحتفال بعيد المولد في ظل الهزيمة، وهو احتفال مطلوب، بلا شك، لكن بصيغة مختلفة ومغايرة تماماً للحال الراهنة. فالمطلوب أن يكون الاحتفاء مناسبة لتذكير عموم المسلمين بالمسؤولية التاريخية التي يستنكفون عنها، وبالفجوة الواسعة بينهم وبين ما جاء من أجله الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلّم).
ذلك، أيضاً، يحيلنا إلى دور علماء الشريعة والفقهاء، وقد اعتكف أغلبهم داخل أسوار الغيتو الجامعي، وفي قاعات الدرس، وحصر مهمته في تصحيح أوراق الامتحانات وتلقين الطلاب شيئاً مكروراً من العلوم الشرعية، وهي حالة خطرة وحسّاسة، تشي بالاستنكاف عن الدور الحيوي المطلوب للعلماء والفقهاء وأساتذة الشريعة خارج أسوار الكليات وداخلها.
يذكر د. محمد أمين المصري أنّ ظاهرة الانفصام بين الفقهية والمفكر من أخطر الآفات التي ابتليت بها الأمة الإسلامية، ذلك يعكس ما نحتاجه اليوم هو أنموذج "الفقيه- المفكر"، الذي يضع حجر الأساس في بناء صرح التغيير.